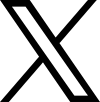نظــــــرة في السيـــــــــاسة
إن السياسة يجب أن تبنى على الأخلاق الحميدة، والفضائل لا على الفساد، والأخلاق السيئة والرذائل، كما في عصرنا هذا، وتكون مجردة عن الأهواء والأغراض كتجرد القاضي من غضبه ليحكم بموجب الحق والقانون.

"السياسة يفرض فيها أن تكون أشرف الآداب إطلاقا" (المعلم الشهيد كمال جنبلاط )
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ".
يقول المعلم كمال جنبلاط : " فالطموح المتسم بالطابع الفردي كثيرا ما يكون شهوة في النفس تحتجب ورائها الأنانية، وبالتالي نقصا تولده حاجة ... ومن يكن له أو فيه حاجة ليتممها، لا تستقيم ولايته، ولا يتصوّب حكمه، ولا يسلم قضاؤه "
ان السياسة في معناها الصحيح، هي "العلم الطبيعي"، الذي تحدث عنه أحد فلاسفة العرب، الفقيه العالم، والطبيب والرياضي (من الرياضيات) والفلكي" أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي"، المتوفي سنة 1198 ميلادية، والذي أعنى به "كتاب النفس"، لان سياسة النفس كما جاء في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم- هي الجهاد الأكبر، والنفس كما قال عنها تعالى : " النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي "، وقد اهتم ابن رشد كغيره من فلاسفة المسلمين العرب، كالفارابي وابن خلدون وابن سيناء والغزالي وغيرهم بقلسفة الإغريق، كأرسطو وأفلاطون وجالينوس وغيرهم، لكون فلسفتهم هي أساس العلوم المنطيقية، والبراهين العقلية، والرياضية، المختصه في تنظيم المجتمع وسياسته، وتبيين الفروق بين فئتين:
الأولى؛ فئة "الخاصة"، تلك النخبة التي تسوس المجتمع، والتي هي "أهل البرهان"
والثانية؛ فئة "الجمهور"، أي العام من الناس، والتي هي " أهل الخطاب الخطابي"، والفئة الخاصة هي القليلة العدد، القادرة على إدراك المعنى الباطن للشريعة كالأنبياء والعلماء، بينما الجمهور يكتفون بالمعنى الظاهر من الأقوال الشعرية والخطابية والجدلية
وكان ابن رشد قد صرح : "إن كلا العملين الأخلاق لأرسطو ، والسياسة لأفلاطون إنما يشكلان جزئين مكملين لبعضهما البعض في العلم السياسي"،
إن سياسة النفس تقييدها بالمثل العليا والأخلاق والفضيلة، مما يجلب لها السعادة والسرور، ورؤية الأشياء على حقيقتها، لان الجسد يحيا بالنفس، وبها يبصر، يسمع، يشم، يذوق، يلمس، فصار هو آلة للنفس، ومن القبيح أن يكون الجسد الذي هو الآلة، أن يدير النفس التي هي بمثابة الصانع أو الآمر والناهي، كمثل أن يدبر الفرس الفارس أو الرعية السلطان ، لذلك من الواجب المفروض على القائد أو المسؤول أن يكون مهذبا لأخلاقه، متبعا مسلك الفضيلة، بعيدا عن الرياء، والكذب، والنفاق، والمخادعة، والمداهنة التي تضر بالمجتمع وتقوده إلى الهلاك، ليتمكن من قيادة المجتمع والأمة إلى شاطيء الأمان،
لذلك السياسة الاجتماعية هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة،
والسياسة لغويا مشتقة من كلمة ساس يسوس سياسة، بمعنى رعى شؤونه، قال في المحيط :"وسست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها"، وهذا هو رعاية شؤونها بالأوامر والنواهي،
فالسياسة هي الإدارة والتسييس وهي مسؤولية كبرى ملقاة على الفرد، ثم الأسرة، ثم العائلة، ثم الحمولة، والقبيلة، والمجتمع، والقرية، والمدينة، ثم الدولة حتى تصل إلى الإمبراطورية، أو حكم الولايات،
والسياسة كانت تعطى لرجال الدين الذين يقودون المجتمع، كالأنبياء والرسل والخلفاء والعلماء، كما في التوراة أنبياء بني إسرائيل كموسى واشعيا وداوود وسليمان عليهم السلام، والقضاة والملوك، وفي زمن الإنجيل يسوع المسيح المعلم، وتلامذته والحواريين عليهم السلام، والرسل ورسالاتهم من بعدهم، والقياصرة الخاضعون للقديسيين، وحتى النظام البابوي والكنسي،
وفي زمن الإسلام شرّع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نظام الدولة، كبيت المسلمين في جمع الزكاوات والخراج والجزية وتنظيم الجيش والسلطة ودور القضاء والمنابر والخطب وتعليم الناس قراءة القران والأحاديث، وإقامة الفروض الدينية، والواجبات كالحج،
ثم خلفه الخلفاء الراشدون والصحابة، ثم الأمويون، والعباسيون، وغيرهم ممن استن بسنن القران والرسول، ليصححوا الاعوجاج، ويعلمونهم ما انزله الله تعالى على الأنبياء والرسل، ويحاربون الجهل، ويبنون بيوت الله والعبادات، ويرغبون الناس في الآخرة، والزهد في الدنيا، ونشر الألفة والمحبة بين الناس، وتقريب الخصوم، وحل المشاكل، لذلك كانت طاعتهم واجبة وهي الولاية لهم، فهم يسوسون المجتمع أو الأمة، ويديرون شؤونهم المدنية والدينية والعسكرية والأمنية والتنظيمية والحياتية بكل نواحيها،
هنا يقول المعلم الفيلسوف شهيد الإنسانية كمال جنبلاط : " السياسة يفرض فيها أن تكون أشرف الآداب إطلاقا ، لان كل تدبير لأمر مادي أو معنوي هو سياسة في المعنى الصحيح للكلمة"،
فأولى الناس في سياسة المجتمع هم رجال الدين، الذين إليهم يرجع في كل الأمور، فهم ورثة الله في الأرض، وعليهم تقع المسؤولية الكبرى والشاقة في القضاء بين الناس، وفي التشريع الديني، من قضايا زواج، وارث، وفض المشاكل، وإصلاح ذات البين، هذا من الناحية الاجتماعية،
أما من الناحية الاقتصادية فهذا يعود إلى الإنسان نفسه، وفي مؤهلاته، وللدين أيضا في الاقتصاد وتشريعاته، واهم شيء عدم الاتجار بالمحرمات، وتعاطي الربا الذي هو سبب ويلات هذا العالم وانحطاطه، وسلب الأجير حقوقه، لذلك اعتبر الفلاسفة الإغريق الاقتصاد السياسي هو أيضا سياسة تدبير الأشخاص والأشياء وإدارتها، لان تدبير الأشخاص لا تنفصل عن الأشياء لاستحالة فصل المدِرِك(بكسر الراء) عن الغرض المدرَك (بفتح الراء) في مجلى العيش وانفعال الإنسان بالمجتمع وبالحياة.
فالنظام والإدارة هنا بموجب ما شرعه الله في الأديان وهو النظام المثالي، ولكن الذي ادخل العطب إلى السياسة هو العلمانية التي دعت إلى عزل الدين عن الدولة، واستبدلت الدين يقوانين مادية تسير على نظام مؤسسات، مما ادخل الفساد على المؤسسات لعدم تقيدها بالدين، ومخافة الله والعمل بما أمر به في كتبه المنزلة، مما سبب الظلم والفساد وإهمال الرعية التي أصبحت بلا مرجع ،
لان السياسة التي اعتمدت عليها الدولة، باتت تخدم مصلحة ذاتية دون الاهتمام بمصالح الفرد، فإقصاء رجال الدين، وعدم الأخذ بمشورتهم، والسماع لأوامرهم، ابعد السياسة عن الحق، وجعلها تتلوث بمفاهيم علمانية تدعو إلى الحريات الفوضية والزائفة دون خوف أو وجل أو رادع ديني، مما جعل رجال الدين يبتعدون عن هذه السياسة الانتهازية والأنانية المخالفة، ويتحايدونها، وصار كل من يقترب من السياسة كأنه يعرّض نفسه لوابل من الاتهامات والأباطيل والنفاق والأكاذيب والمكر والحيل،
فبات السياسي وكأنه دجال ماكر ومحتال يموه على الناس، ويدعوهم للإيمان بقدراته التضليلية، وكلها لأسباب مصلحة ذاتية وانتهازية أنانية، ما تلبث حتى تظهر حقيقتها كالجفاء على وجه الماء،
وعلى هذا الأساس أيضا فسّر المعلم كمال جنبلاط فشل الديمقراطيات في الغرب، وفي الدول الشيوعية والاشتراكية( كان كمال قد تنبأ بسقوط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي )، بقوله : "يعود إلى إهمالهم مفهوم النخبة ودور النخبة في تكوين المجتمع والدولة وفي توجيه الإنسان، فأنظمة الغرب تنزع إلى فوضى الشورى الديمقراطية باسم الحرية ، وأنظمة الشرق تنزع إلى الديكتاتورية الفردية والاتوقراطية باسم الحزب أو الطبقة أو المجتمع وباسم الحرية والتحرر أيضا وفي النهاية تنقضها وتناقضها،
ويضيف متسائلا : ألم تفشل الشيوعية والاشتراكية نسبيا، في عصرنا، في بناء الإنسان والمجتمع متكاملين لأنهما لم يأخذا بعين الاعتبار القيم الاجتماعية والمعنوية والروحية والإنسانية الدائمة، التي كانت ولا تزال عبر التاريخ تشكل أهدافا لتطور التيار الحي، بالرغم من أن الشيوعية والاشتراكية هما بحد ذاتهما مباديء وعقائد سامية ؟ "،
فالسياسة حسب دراسة المعلم كمال جنبلاط، هي مسلك شريف، لان لها علاقة بقيادة الرجال وتوجيههم، وتنبع عن معرفة عقلية صحيحة، وتهذيب شعوري، وتجرد عن الأهواء، وعن المصالح الفردية والفئوية والحزبية، ومن استيعاب لتجربة الآخرين، وتجربة الحياة، ومن الاسترشاد بالمثل العليا،
إن السياسة يجب أن تبنى على الأخلاق الحميدة، والفضائل لا على الفساد، والأخلاق السيئة والرذائل، كما في عصرنا هذا، وتكون مجردة عن الأهواء والأغراض كتجرد القاضي من غضبه ليحكم بموجب الحق والقانون ليصبح بذلك موضوعيا، يقضي بالعدل فينصف المظلوم، ويغرم الظالم،
والسياسة الحكيمة العادلة تنشي مجتمعا فاضلا منضبطا يسري في عروقه الخير، والعمل الصالح،وعلى هذا الخير بنى افلاطون جمهوريته الفاضلة المبنية على الفضيلة التي هي الاخلاق الرفيعة والمثل العليا، فقد وضع معلمنا أفلاطون حجر الأساس لسعادة المدينة، والتي تتلاقى مع سعادة المواطن، الذي هو باعتبار أفلاطون “الدولة الحقيقية، لأن الدولة تتماسك بنظام، وهذا النظام يجب أن يكون سليما تتعاون فيه جميع المؤسسات، لتخدم الإنسان وتقوده الى السعادة المثالية، لا السعادة السلبية، المتمثلة بالمادة، وكذلك الإنسان فهو مبني على نظام وعلى جميع الأعضاء أن تكون سليمة، لتخدم ذاك الإنسان، وتوصله إلى السعادة، لأن دولة أفلاطون جاءت بحكم العقل الخالص، المتجسم في طبقة الملوك والفلاسفة، والمبنية على المعرفة الكليّة للأشياء المتمثلة بالحكمة والشجاعة والعفة والعدالة،
فالحكمة فضيلة العقل وهي السلطة في الدولة ، والعفة فضيلة القوة الشهوية، وهي المجتمع الإنساني في الدولة، ويتوسطهما الشجاعة وهي فضيلة القوة الغضبية، وهي الشرطة العسكرية في الدولة للحفاظ على الأمن، فالقوة الغضبية تعين العقل على الشهوية، فيقاوم إغراء اللذة ومخافة الألم، وعندما تتحقق كل قوة من هذه القوّات الثّلاثة، العاقلة والغضبية والشهوية فضائلها التي هي الحكمة والشجاعة والعفة، تتحقق عندها في المرء الفضيلة الرابعة التي هي العدالة، والتي هي الحكم المثالي والنزيه في الدولة، دون تطرف، أو عنصرية، أو ميل إلى الظلم والإرهاب أوسياسة البطش والقمع والتعسّف، بل المساواة التّامة بين جميع فئات الشعب دون تمييز لدين أو لون، لأن أفلاطون يقول:”غايتنا من إقامة الدولة إسعاد الجميع،لا إسعاد طبقة”، فالفضيلة الرابعة التي هي العدالة هي باب السعادة، لان تربية أفلاطون تربية ممتعة، دون إكراه مما يميت معنى الحرية.
وبفكره هذا وضع أسس مدينة، دولة مثالية، مبنية على الفضائل، التي هي الحقيقة والصدق، لا إمبراطورية، ولا قومية، مبنية على الرذيلة التي هي الكذب وإنكار الحقيقة، والمؤسسة على أسس مادية، وتلك المدينة هي “جمهورية أفلاطون” او بالأصح مملكة الرب المثلى على الأرض يسودها الخير والسلام والطمأنينة والسعادة والتي هي اعني السعادة المطلب الذي ينشده كل البشر؛ والتي طلبها الأكثرون في غير موضعها فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء صفر اليدين كسير القلب خائب الرجاء، لأن السعادة في الحقيقة شيء ينبع من داخل الإنسان يشعر به بين جوانبه فهو أمر معنوي لا يُقاس بالكم ، ولا يشترى بالدينار والدرهم ولا بكنوز الدنيا كلها ؛ بل هي صفاء نفس وطمأنينة قلب وراحة ضمير وانشراح صدر، وليست السعادة كما يظن الأكثرية في علوم الحياة الدنيا من التكنولوجيا والتطور والتحرر التي وصل إليها الغرب ناسيين أن السعادة في غير هذا وذاك .
فالرعية مرآة الراعي والمسؤول، فإذا اعوج اعوجت، واذا استقام استقامت، وكلما تغيرت أحوال الرعية من سيء إلى أسوأ، فهذا يدل على السياسة التي يتبعها السياسيون، سياسة عقيمة منقادة لأهواء وأغراض ذات منفعة ذاتية، مما يجلب تفكيك المجتمع وتمزيقه وبالتالي ضياعه،
لذلك السياسي القائد يجب ان يكون قاضيا عادلا، وحاكما نزيها، وشيخا حنيفا، وناسكا صوفيا لا يطمع بملاذ الدنيا وشهواتها، ولا عزها ولا جاهها، لا يطمح بالوصول الى منصب ما، بل هدفه الوحيد تنفيذ الأمانة الملقاة على عاتقه في إدارة المجتمع، والحرص على مصالحه، والقيام بالواجب على أتم وجه، وبرضى وجدان،
لذلك يقول المعلم كمال جنبلاط : " فالطموح المتسم بالطابع الفردي كثيرا ما يكون شهوة في النفس تحتجب ورائها الأنانية، وبالتالي نقصا تولده حاجة ... ومن يكن له أو فيه حاجة ليتممها، لا تستقيم ولايته، ولا يتصوّب حكمه، ولا يسلم قضاؤه "،
ومن هنا يطالب هذا الفيلسوف بان يكون الحكم والإدارة والقضاء في يد النخبة الحقيقية في المجتمع، لا تلك الوجوه التي تفرزها معظم الأحيان المطامع، وانخداع المواطنين، والدجل السياسي، وانتهازية المواقف والفرص، ودعاوة المال ودعامة الجاه"،
ومن هنا ما يتحدث به السياسي للجماهير، عن الديمقراطية وسواها، من المفاهيم والشعارات الطنانة، المعسولة والمزركشة، بشتى الوعودات، أضحت تقود الناس على غير هدى،
وهذا ما نراه في عالمنا الذي يسميه البعض بـ "الحضاري أو المتطور" من قيادات انتهازية، همها الوصول إلى أطماع ذاتية، ورغبات فئوية، فتنغص عيش مجتمعاتها بسبب سوء الإدارة والفساد، فيتحكم بالمؤسسات مدراء فاسدون والنتيجة فوضى عارمة في شتى المجالات،
لذلك يقول المعلم كمال جنبلاط : " فالسلطة علاقة جدلية بين القائد والموجه والحاكم وبين جمهور المحكومين من المواطنين، وفي هذه العلاقة أخذ وعطاء، وتنافر واستقطاب، وفعل وانفعال، وكل ذلك يجري على الصعيدين الشعبي والقيادي في ضوء قيم معنوية ثابتة هي قيم العقل والمجتمع .. فإذا لم يتوفر للقيادة هذا السمو في العلاقة وهذه الأصالة بالانتساب إلى الخير، وهذه الرفعة في تصور العقل، لأهداف الحياة، واستيعاب غاية العيش على حقيقتها، فكيف تسلم القيادة من الشطط، وكيف تستطيع أن توجه الإنسان، وكيف يمكن أن يصح للإنسان حكم أو قضاء أو أي سلطان ؟ "،
لذلك في نظر المعلم كمال جنبلاط الديمقراطية والسيادة الشعبية، تبقيان كلمة جوفاء إلى أن تتوفر لها النخبة القائدة لتحقيقها عمليا،
وذلك لان المجتمع هو وحدة تكاملية كتكامل أعضاء الجسد، إذا تلف عضو اختل عمل الجسد فيصبح عاجزا عن إدارة ذاته مما يسيء لسلامته، فيصير معتلا،
والقائد هنا بمثابة العقل السليم والمجتمع كالجسم الصحيح، فإذا تشوش العقل يختل أيضا تدبير الجسم، ويصير كالإنسان المجنون، أو السكران، غير منتظم، مما يجعل الناس تخاف منه لفقدان توازنه وعشوائية تمشيه،
وأخيرا السياسة الحكيمة المربوطة بعقل متصل بالدين، هي الطريقة الصحيحة لإدارة المجتمع، وبالتالي الموصلة به إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ومن هنا دعوة العلمانية إلى الفوضوية بفصل الدين عن الدولة وهو سبب تدهور هذا العالم، واختلال نظامه،
لان العلمانية هي بمعناها الصحيح "اللا دينية"، التي تدعو إلى محاربة الأديان المفطورة في جبلات البشر، وقمعها من نفوسهم، وبالتالي نزع الإيمان منهم، فيصبحون بلا رادع، لذلك هي سبب الحروب والفتن الطائفية وزعزعة امن العالم، لأنها جاءت بما يخالف القواعد والأسس التي بنى الله تعالى هذا الإبداع الكوني العجيب، والمرتبط كل الارتباط بنظام العقل المجرد عن الهوى، والشهوات، كتجرد عقل القاضي من حرارة الغضب والطيش والنزاقة والميل والعنصرية، ليحكم بالعدل ويظهر الحقيقة ويبيّن الظالم من المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه .