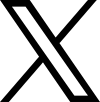العام الجديد 2026 جديدٌ يذكر أم قديمٌ يُعاد؟
بصرف النظر عمّا إذا كانت الانتخابات البرلمانيّة القادمة في إسرائيل، ستجرى في موعدها القانونيّ، وهو الثلاثاء السابع والعشرون من تشرين الأول أكتوبر 2026، أم إذا كانت ستؤجّل بفعل أوضاع أمنيّة، وربما حرب مع إيران أو حزب الله تستغلّها الحكومة عامّة ورئيسها بنيامين نتنياهو خاصّة ذريعة

لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمّى، أو أن التشريعات المتواصلة في إسرائيل ووسط غياب أيّ قدرة لمعارضي الحكومة على تجنيد معارضة جماهيريّة لوقف الحكومة عند حدّها. وبخلاف ما كان مع انطلاق قطار الانقلاب الدستوريّ إلى نتيجة يخشاها كثيرون، وهي أن لا تُجْرى انتخابات أخرى في البلاد، أو أن تكون الانتخابات القريبة الأخيرة، بنمطها الديمقراطيّ والحرّ والمتساوي والعامّ وفق القانون الإسرائيليّ، وبهدفها وهو أن يحصل الشعب على حقّه وصلاحيته في تحديد هويّة من سيحكمه، أو يتولّى سدّة الحكم في السنوات الأربع القادمة، بل بهدف آخر هو الاستيلاء على السلطة بالقوّة وتزييف قرار الناخب،
واستغلاله للسيطرة على الحكم بكلّ ثمن، فإن هذه الانتخابات، وكما قلت بغضّ النظر عن موعدها، تحمل أهميّة خاصّة ومميّزة أكثر من كونها عمليّة ديمقراطيّة، أو يومًا يمارس الناخب فيه حقّه الديمقراطيّ في الانتخاب، بل إنه يمكن الجزم وباعتراف الجميع جهرًا أو صمتًا، أن هذه الانتخابات تجرى في وقت ووضع تقف فيه إسرائيل على مفترق طرق، وأمام منعطف حاسم، خاصّة بعد التحذيرات التي أطلقها البروفيسور أهارون باراك، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا في إسرائيل، والتي قال فيها إن إسرائيل لم تعد دولة يسودها النظام الديمقراطيّ الليبراليّ،
بل إنها دولة يخيّم عليها حكم الرجل الواحد والحاكم الأوحد وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك وسط غياب للفصل بين السلطات خاصّة وأن السلطة التشريعيّة أصبحت أداةً طيّعة لتنفيذ قرارات السلطة التنفيذيّة، وليس مراقبتها وعلى ضوء حملات التحريض على الجهاز القضائيّ التي تهدف إلى إضعافه، وزرع بذور الخوف في نفوس أعضائه وجعلهم تحت سلطة السياسيّين. وبالتالي منعهم من إبداء أي رأي قضائيّ لا يتساوق ومواقف من عيَّنَهُم، ومع ازدياد أعداد من يعتبر أو يخشى، والبعض يريد،
أن تكون الانتخابات المقبلة الأخيرة بصيغتها الديمقراطيّة المعروفة، على ضوء ما تشهده إسرائيل من تشريعات محمومة وانهيار المعايير الديمقراطيّة والأخلاقيّة المؤسساتيّة العامَّة، والهجوم الشرس على القضاء، وتسييس أجهزة الأمن والشرطة، خاصّة منذ استلام إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي وعمله الذي اصبح جليًا وخلافًا للتوافقات بينه وبين المستشارة القضائيّة للحكومة، للسيطرة على سياسات الشرطة والتعيينات فيها وتحويلها عبر الحرس القوميّ إلى مليشيا خاصّة تأتمر بأمره، وتسليم مفاتيحها لضباط من الصفّ الثاني والثالث يدركون في قرارة أنفسهم أنهم لم يكونوا ليحصلوا على مناصبهم لولا ولاؤهم المطلق والأعمى له،
وتنازلهم عن مبادئ العمل الشُرَطِّي الصحيح. وإضعاف المؤسّسات الثقافيّة وكمّ الأفواه وتضييق مساحة حريّة التعبير، وتصاعد خطاب التهديد والتحريض، فضلًا عن النيّة المعلنة لتخريب العمليّة الانتخابيّة نفسها عبر إقصاء مرشّحين وأحزاب، ممّا يعني أن محاولات إلحاق الضرر بنزاهة الانتخابات أو المسّ بها، ستتفاقم كلما اقتربت ، إضافة إلى وجود مؤشّرات مقلقة، مثل تبنّي سياسات اقتصاديّة وأخرى منها ما يتعلّق بقانون التجنيد، أو كما يسمّيه معارضوه بقانون الإعفاء من الخدمة العسكريّة لليهود المتزمّتين الحريديم، تمسّ بشكل كبير حتى بالقاعدة الحزبيّة والانتخابيّة، وعدم الاكتراث لكثرة الفضائح وقضايا الأخلاق والفساد، ومنها قضية "قطر غيت"،
أي شبهات التعاون مع قطر، خلال الحرب الأخيرة في غزة، وحصول بعض المستشارين الشخصيّين والمقربّين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيليّ على مبالغ ماليّة كبيرة مقابل تقديم خدمات "تلميع إعلاميّ"، وبالتالي تتحوّل الانتخابات من قضيّة يجب تحقيق الفوز النزيه فيها إلى عمليّة محسومة مسبقًا نتيجتها الحتميّة فرض واقع سياسيّ جديد بالقوة، عبر تهميش الناخبين عامّة، خاصّة على ضوء تحذيرات القاضي المحافظ نوعم سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا حول احتمالات حقيقيّة وملموسة للمس بنزاهة الانتخابات، بالتعاون مع الناخبين الذين يشكّلون القاعدة الانتخابيّة للحكومة الحاليّة.
الانتخابات القادمة، والتي تنبع أهميّتها أيضًا من أنها تتزامن مع انتخابات منتصف الفترة في الولايات المتحدة الأمريكيّة والتي يريد دونالد ترامب تحقيق إنجازات فيها قد تكون مرتبطة بالتغيير الذي يشهده الشارع الأمريكيّ بحزبيه الديمقراطيّ وحتى الجمهوري وخاصّة الجيل الشاب، بكل ما يتعلّق بالموقف من إسرائيل، وهي انتخابات تُجرى مع مرور عامين من الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة الأخيرة عام 2024، ويقينًا أكثر من أيّ انتخابات سبقتها هي نقطة مفصليّة لن يكون ما بعدها مشابهًا لما كان قبلها، بل على الأغلب ومهما كانت نتائجها فإن القادم أسوا، وهي انتخابات ستدور حول نتائجها النزاعات، وسيكون البون بين من يقبل نتائجها ومن يعتبرها مزوّرة ومزيفة وغير نزيهة غير قابل للردم، بل أقرب إلى الطلاق البائن بينونة كبرى منه إلى الفراق العاديّ والخلاف السياسيّ، خاصّة على الصعيد الداخليّ وبكلمات أخرى غير دبلوماسيّة على صعيد العلاقات الداخليّة بين المجموعات الطائفيّة اليهوديّة، أو بين معسكري اليمين واليسار، مع ضبابيّة هاته التسميات، وهي علاقات لم تتحسن، بل إنها انتقلت من سيء إلى أسوا حتى تبدو غير قابلة للتصحيح والإصلاح، بل وصلت حدّ القطيعة الدائمة، والحديث عن دولتين، إسرائيل للمركز واليسار ويهودا لليمين والمستوطنين والمتديّنين، دون أيّ حديث عن أكثر من 22% من مواطني الدولة وهم من العرب، وهذا ما سنعود اليه،
فضلًا عن حالة التخوين المتبادل بين مؤيّدي الحكومة الحاليّة ومعارضيها، ومن هنا أقول ان عام 2026 والذي بدأ قبل أيّام معدودة، لن يكون عامًا كتلك الأعوام التي سبقته، ولن يكون سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، مجرّد صفحة تُطوى في رزنامة السياسة الإسرائيليّة، بل إنه عام ستتّضح فيه معالم المستقبل وسيتّضح فيه ما إذا كانت إسرائيل ستبقى دولة مستقلّة وذات طابع شبه ديمقراطيّ،
رغم كل ما حدث حتى اليوم، ورغم كافّة الخلافات والاختلافات الداخليّة والسياسيّة، أي كيانًا ودولة لليهود جميعًا يمكنهم الحياة فيها، أم أنها ستواصل الانزلاق إلى مستنقع الخلافات الداخليّة وربما المواجهة الداخليّة المتواصلة، ومعها الحرب الدائمة على جبهات عديدة كانت في العام الماضي 2025 سبع جبهات، وتقلّصت إلى أربع جبهات هذا العام، وصولًا إلى تعميق حالة الانقسام الداخليّ والإقصاء المتبادل يهوديًّا، وكذلك العزلة الدوليّة، وزيادة الأعباء الاقتصاديّة والديمغرافيّة، وشرعنة الفساد السياسيّ ومخالفة القانون، ومواصلة نحو 30% من مواطنيها إقصاء أنفسهم عن المساهمة الاقتصاديّة والعلميّة والتشغيليّة وهم الحريديم، وعدم دمجهم في الخدمة العسكريّة، وكلها أمور إذا اجتمعت كلها أو يكفي بعضها، سوف تهدد حصانة الدولة وقوتها وتمسّ بإمكانيات واحتمالات استمرار وجودها كدولة مزدهرة تكنولوجيًّا ونامية اقتصاديًّا تريد العيش بسلام بين طوائفها ومواطنيها أولًا، ولا تريد العيش على حدّ السيف مع جاراتها ثانيًا والعالم ثالثًا، ومن هنا لن تقتصر الانتخابات المقبلة على تحديد هويّة رئيس الوزراء والأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكوميّ وتلك التي ستبقى في صفوف المعارضة فحسب، بل إن نتائجها ، ستحدّد أيضًا،
ما إذا كانت الدولة ما زالت قادرة على مراجعة الذات، وترتيب الحسابات الداخليّة، واتّخاذ خطوات تهدف إلى تنفيذ إصلاحات داخليّة عميقة وربما قاسية لكنّها ضروريّة ، منها القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب وبين الخلاف السياسيّ والإقصاء، وبين الاختلاف الأيديولوجيّ والاقتتال الداخليّ. والأهم من ذلك الشجاعة على التمييز بين المصلحة الوطنيّة طويلة الأمد والبقاء السياسيّ قصير الأجل، وتفضيل الأولى على الثانية بعكس ما يحدث منذ بداية العام 2023 أي بداية عهد الحكومة الحاليّة.
وكم بالحري بأن تفضيل المصلحة العامَّة والوطنيّة بعيدة المدى على تلك الحزبيّة والسياسيّة قصيرة المدى، يحتّم إعادة النظر في كافّة السياسات والأحداث والتطوّرات، وأقصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسميّة حقيقيّة ليس فقط في أحداث 7 أكتوبر، بدلًا من المحاولة الحاليّة لاستبدال لجنة التحقيق الرسميّة بلجنة فحص حكوميّة، وهي خطوة ليست إلا تهرّب من تحمّل المسؤوليّة وتصحيح المسار، خاصّة وأنها بتركيبتها وصلاحياتها ستكون بعيدة عن استخلاص العبر اللازمة، كما أن نتائجها لن تُنهي الجدل الداخليّ،
بل ستزيده تعقيدًا وخطورة، على ضوء ما سبقها من ادّعاءات وحجج اتّضح أنها واهية ومنها أن التحقيقات مستحيلة في زمن الحرب، وأن النظام القضائيّ نفسه يجب أن يخضع للتحقيق، تمامًا كما الحركة الاحتجاجيّة المناهضة للانقلاب الدستوريّ، وكلها محاولات مفضوحة لتوزيع المسؤوليّة على الجميع في أحسن الحالات رغم أنها في واقع الأمر لا يمكن أن تتوزّع على الجميع، بل إنها مسؤولية قمة رأس الهرم السياسيّ والذي يضع كافّة السياسات بما فيها العسكريّة، وليس ذلك فقط بل في كافّة مجريات الأعوام الأخيرة ومسيرة الانقلاب القضائيّ الدستوريّ، وتسييس الجيش والشرطة وربما أيضًا الجهاز الأمنيّ، وقمع الحريّات وضمّ مجموعات متديّنة ويمينيّة ترفض الانصياع للقانون المدنيّ، أو حتى لتعريف إسرائيل نفسها بأنها دولة يهوديّة وديمقراطيّة، بل الإصرار على جعلها دولة خاضعة للشريعة اليهوديّة، أو دولة لليهود فقط.
ليس ذلك فقط فمراجعة الذات وضرورة الفحص الدقيق، وربما عبر لجنة تحقيق رسميّة أيضًا ، يجب أن تصل ربما كافّة السياسات والتوجهات، والتي ازدادت، بل تضاعفت في عهد الحكومة الحاليّة، وتشمل تلك الاجتماعيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والتي تتجاهل عمدًا أكثر من 20% من مواطني الدولة أي المواطنين العرب ، ونتيجة ذلك وبعد 77 عامًا من قيام الدولة انعدام المساواة مواطنيها العرب واليهود، ومن هنا المطلوب من دولة إسرائيل، وعلى ضوء انقساماتها الداخليّة، وضع حدٍّ لسياسات الإقصاء والتمييز الممنهج والمستمر ضد المجتمع العربيّ، وأن تتقبّله كجزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيليّ، وقبول أو على الأقلّ الاستماع إلى انتقاداته وتحفّظاته على سياسات الحكومات المتعاقبة،
خاصّة وأن كافّة الإحصائيّات والاستطلاعات، وكذلك مواقف المجتمع العربيّ خاصّة منذ السابع من اكتوبر عام 2023، أكّدت التزامه التامّ بانتمائه المدنيّ وانصياعه للقانون، ورغبة الغالبّية العظمى من مواطنيه في الاندماج في حياة الدولة ومرافقها الاقتصاديّة والأكاديميّة والتشغيليّة وحتى الحياة السياسيّة والمشاركة في الائتلاف والحكومة والتأثير السياسيّ، وذلك من منطلق مواطنتهم الحقّة وإدراك معظمهم أن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي بإمكانه أن يضمن لهم حياة كريمة وحرّة وآمنة كأقليّة لها مكانتها وأهميّتها في دولة يهوديّة ديمقراطيّة،
وهذا ليس بجديد، ويؤكّده ما حدث عام 1954، ومحاولة وزير الأمن آنذاك، بنحاس لافون، فرض قانون التجنيد الإجباريّ على جميع مواطني البلاد، بمن فيهم العرب، واستجابة نحو 72% من المواطنين العرب الذين تلقوا أوامر تجنيد إلزاميّة، وتوجّههم إلى مكاتب التجنيد ، ليتوقّف ذلك بعد صدور أمرٍ بعدم تجنيدهم، مع الإشارة إلى أن معظم المتخلفين من العرب عن التجنيد كانوا من الطائفة الدرزيّة، لذلك تعرضوا للملاحقة من قبل الشرطة العسكريّة.
وليس صدفة أن يؤكّد معظم الخبراء في علم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وبغضّ النظر عن مواقفهم ومنطلقاتهم الحزبيّة، ضرورة بل فائدة الاستثمار الحكوميّ بشكل كامل ومستمر في المجتمع العربيّ، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق الاندماج ووضع حدّ لسياسات الإقصاء ، ما من شأنه أن يرفع ويحسّن مستوى معيشة المواطنين العرب، ومستوى وجودة التعليم والبنى التحتيّة في المجتمع العربيّ،
لتقترب إلى مستواها في المجتمع اليهوديّ، وفي مقدّمة ذلك الاستثمار وتخصيص موارد ضخمة لمكافحة الجريمة والعنف ووضع هذه القضيّة في مقدّمة سلّم أولويّات الدولة و بالتعاون الكامل مع السكان، لضمان أمن داخليّ وحياة آمنة، وكذلك العمل على رفع رواتب المعلّمين، وتطوير المناهج الدراسيّة، ودمج المعلمين العرب في المدارس اليهوديّة. وأعود هنا لأؤكّد أهميّة تعزيز وتنجيع عملية تعلّم اللغة العبريّة بين العرب واللغة العربيّة بين اليهود كلغة دراسيّة إلزاميّة، وكلها خطوات تقلّل من البطالة والشعور بالإقصاء،
وتصبّ في مصلحة سحب البساط من تحت أقدام الجماعات الخارجة على القانون، خاصّة بعد عام دامٍ تمّ فيه تحطيم كافّة الأرقام القياسيّة التي جعلت من العام 2025 عامًا قياسيًّا في عدد جرائم القتل ، مع الإشارة هنا إلى التدهور المتواصل في مجال العنف وانعدام الأمن الشخصيّ في المجتمع العربيّ، وهو ما تعكسه المعطيات ، وملخّصها أن العام 2015، شهد 4 جرائم قتل في المجتمع العربيّ مقابل كل جريمة قتل في المجتمع اليهوديّ وهي نسبة كانت مرتفعة للغاية، لكنّها سجّلت منذ ذلك الوقت ارتفاعًا غير مسبوق ووصلت عام 2024 إلى 14 جريمة قتل بين المواطنين العرب مقابل كل جريمة قتل بين السكان اليهود،
وهي حالة تتحمّل مسؤوليّتها أولًا السلطات إضافة إلى المسؤوليّة الداخليّة، وهو ما أكّده هذا الأسبوع النائب منصور عباس من القائمة العربيّة الموحّدة ، حول ضرورة أن يتحمّل المجتمع العربيّ حصّته الواضحة من المسؤوليّة حول تفشّي العنف، مضيفًا أن على المجتمع العربيّ بكافّة شرائحه ممارسة النقد الذاتيّ، فالقتلة منه والضحايا كذلك، لكن هذا لا يعني إعفاء الدولة من واجباتها والإشارة إلى ممارسات رسميّة خاصّة في عهد الحكومة الحاليّة،
ومنذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القوميّ، تشجّع العنف، أو ترمز إلى عدم الاكتراث بذلك، ولعلّ الأخطر من ذلك هو أن الأغلبيّة اليهوديّة لا تُلقي باللوم على وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير الذي تفاقمت هذه الظاهرة في فترة ولايته، كما كانت قد بدأت قبلها ولكن بضحايا أقلّ، بل تُلقي باللوم على المجتمع العربيّ نفسه وتتّهمه أنه لا يسمح للشرطة بمكافحة العنف، ولا يتعاون مع الشرطة، بل يعرقل عملها ، إضافة إلى اعتقاد البعض أنها ظاهرة تعكس مشكلة ثقافيّة تخصّ المجتمع العربيّ، بمعنى أنها ظاهرة متأصّلة لا يتحمّل أحد مسؤوليّتها، لا الدولة، ولا سياسات التمييز، ولا الشرطة، ولا بن غفير، بل إنها انعكاس لحضارة وثقافة تسمح بالعنف والقتل.
إقليميًّا وسياسيًّا، ستكون السنة الحاليّة مفصليّة على إسرائيل أن تستخلص فيها العبر من العامين الأخيرين، وأن تدرك فلسطينيًّا وعلى ضوء الحرب في غزة ، ضرورة إنهاء مقاطعتها للسلطة الفلسطينيّة في كل ما يتعلّق بغزة والضفة الغربيّة على حدّ سواء، والسعي إلى جعل السلطة الفلسطينيّة شريكًا في عمليّة استبدال حركة حماس بحكومة مدنيّة فلسطينيّة وإنهاء الحرب وإقامة كيان فلسطينيّ مستقلّ، فطالما واصلت إسرائيل رفضها التعاون مع السلطة الفلسطينيّة، فلن يتحمّل أحد مسؤوليّة الحكم في غزة، وستبقى حماس، حتى وإن ضعفت عسكريًّا، القوّة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ، فالسلطة الفلسطينيّة هي الجسم الفلسطينيّ الوحيد القائم فعليًّا، الذي يمتلك خبرةً في الحكم، وآلياتٍ أمنيّة، وعلاقات مع إسرائيل، وشرعيةً كافيةً في نظر المجتمع الدوليّ، ما يؤكّد زيف الادّعاءات حول مساعٍ لإيجاد قيادة محليّة جديدة في غزة والضفة أو عشائر، أو استمرار الحكم العسكريّ. أما إقليميًّا ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة في الجيش حول استعدادات لمواجهة أي طارئ على أربع جبهات.
على إسرائيل أن تحسم أمرها حول سياساتها وتوجهاتها بفعل أمرين أوّلهما الحقيقة الواقعة والتي تمخّضت عنها جولات دونالد ترامب في الخليج، وعلاقاته المميّزة مع قطر وتركيا وخاصّة مع السعوديّة، ومعناها أن إسرائيل ليست وحدها في الساحة الأمريكيّة كما كانت في الماضي، بل تزاحمها هناك مجموعة من ثلاث دول لا تربطها بها علاقات سلميّة ولا علاقة حرب، وإنما خصومة ومنافسة. وهذا يجب أن يدقّ ناقوس الخطر لدي القادة الإسرائيليّين في العام الجديد،
ويحتّم وضع استراتيجيّة واضحة لمستقبل إسرائيل الاقليميّ، مع الإشارة إلى أن هذه الدول الثلاث، أي المملكة العربيّة السعوديّة، وقطر، وتركيا شريكة رئيسيّة مع الولايات المتحدة في المصالح في سوريا، وتحرص على استمرار الهدوء هناك ولكل منها أهدافها الخاصّة، كما أنها في نفس الوقت، ورغم التناقض الظاهر للمصالح في سوريا، شريكة متفاهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها جميعها تسعى إلى تحقيق تقدم سريع في هذه العمليّة، بغضّ النظر عن المنطلقات لهذه الدول الثلاث السياسيّة، لكنها بالنسبة لترامب سياسيّة واقتصاديّة في نفس الوقت، فهو بحاجة إلى أموال دول الخليج، وهي بدورها تحتاج إلى دعمه الدبلوماسيّ وقوته العسكريّة،
وإذا ما أدرك ترامب أن استمرار القتال في جبهات ما وهو ما تخطط إسرائيل لفعله وفق تصريحات قياداتها، سوف يؤخّر تحقيق المكاسب السياسيّة والاقتصاديّة وربما الشخصيّة التي يريدها ، فقد يلجأ إلى وقفها عند حدّها وإلزامها بقبول مواقفه دون تردّد، كما فعل بالنسبة لوقف إطلاق النار في غزة والانتقال قريبًا إلى المرحلة الثانية.
ختامًا، ما سبق هو خطوات سوف تضطرّ إسرائيل لحسم موقفها منها هذا العام، لكنها خطوات يربطها قاسم مشترك واضح، ومن هنا الخطورة، فهي خطوات لا يمكن تحقيق أيّ منها في ظلّ الحكومة الحاليّة، فحكومة نتنياهو والمصالح السياسيّة والشخصيّة له ولمركّباتها وائتلافها، تبدو عكسها ، ففي غزة ستكون النتيجة العودة إلى الحرب، أو تقوية حماس من خلال غياب بديل، ورفض الحديث عن اليوم التالي واستمرار رفض أي دور للسلطة الفلسطينيّة ،
وداخليًّا ُستعرقل هذه الحكومة أيّ تحقيق جادّ في أحداث السابع من أكتوبر وستواصل كما هو ظاهر في الأسابيع الأخيرة الانقلاب الدستوريّ، وستعمّق عدم المساواة، وتُسرّع وتيرة الاستيطان، وتُقصي المواطنين العرب من إسرائيل، وتُنَفّر دول العالم. وهو ما انعكس في سيل الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة وتفاقم المعارضة الجماهيريّة في الدول الأوروبيّة لسياساتها، فهل ستدرك هذه الحكومة صحّة قول الفنان والكاتب، والروائيّ باولو كويلوإن الوسيلة الوحيدة لاتّخاذ القرارالصحيح هو الاعتراف بالقرار الخاطئ،
أي هل ستدرك أخطاءها السابقة وتصحّحها، وهو الحال بالنسبة لنتائج الانتخابات، فهل ما سيكون هو تكرار لما كان، أم فيه جديد؟؟ ولا بدّ من الإشارة بأن الدور للمواطن العربيّ في هذه البلاد قد يكون بيضة القبَّان في انتخاب حكومة تختلف كليًّا عن الحكومة الحاليّة، وتعيد الرشد إلى المجتمعين اليهوديّ والعربيّ بأن الحياة المشتركة المبنيّة على كرامة الإنسان بغضّ النظر عن انتمائه الدينيّ،
أو القوميّ أو الفكريّ أو السياسيّ هي الأساس في دولة يسود فيها الأمن الشخصيّ والمساواة في مصادر الرزق والتعليم والتقدّم، دون الإقصاء والحقد والكراهية على أرضيّة دينيّة ولنذكر بأن جميع أنظمة الحكم الدكتاتوريّة والدينيّة والمتزمّتة لم يدُم حكمها، وحتى دولها أو أمبراطورياتها إلى الأبد.