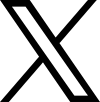خطّة ترامب بين فرحة الإعلان ورهان التنفيذ في الميدان
دون الخوض في جزئيّة القبول المتعلّقة بخطّة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب التي هي في الأساس تسريح المخطوفين الإسرائيليّين والأسرى الفلسطينيّين المحكومين بالسجن المؤبّد، فضلًا عن وقف إطلاق النار في غزة، وهي جزئيّة انتظرها الجميع بلهفة باعتبارها الأهمّ في القضيّة.

وبعيدًا عن التقليل من أهميّة القبول أو الرفض رغم أن ذلك ليس الأهمّ في نظري، طغى على النقاشات والمراجعات، وربما لأسباب مفهومة وواضحة خاصّة وأنه يدور الحديث عن حرب مقيتة بلغت عامها الثاني لتدخل الثالث، الاهتمام بالنظريّة والنصّ بدل المراجعة الحقيقيّة والواعية والنظر إلى النتيجة، أي الخروج من قوقعة النظريّة والنصوص المكتوبة، والتي قد تكون جيّدة وسليمة وتبشّر خطّيًّا على الأقلّ بنوايا حسنة، وصولًا إلى البحث الجديّ في قضيّتين أوّلهما البيئة والوتيرة والترتيب الزمنيّ والمكانيّ، التي صيغت فيها هذه النصوص.
وهي هامّة للغاية باعتبارها قد تكشف بعض الخبايا والأسرار، وثانيهما قضيّة التطبيق والنتيجة النهائيّة، وأقول هذا استنادًا إلى أمرين ، أوّلهما الحقيقة الساطعة، والتي يبدو، وللأسف أن شرقنا وأعني الدول والشعوب العربيّة لم تذوتها بعد، وأعني هنا أن السياسة الدوليّة خاصّة، تستند إلى خليط يبدو لنا في الشرق، كم تغلب عليه العاطفة والأحاسيس وقيم احترام الكلمة والنصّ المكتوب كأنّه آيات مقدّسة، ودون الخوض في ما وراء السطور والكلمات،
غير مفهوم تتشابك أحيانًا وتتكامل أحيانًا أخرى فيه النصوص النظريّة والمصالح الواقعيّة، أو ما يسمّيه علماء وخبراء العلوم السياسيّة بأنه الجدل الدائم في السياسة بين النظريّة والتطبيق، أو بين الصواب وإكراهات الواقع. والمقصود هنا أن السياسة باعتبارها فنّ الممكن، تبدو نظريًّا وكأنها تهدف داخليًّا إلى تنظيم المجتمعات على أسس العدل والحريّة والمساوة والنزاهة، وخارجيًّا إلى إحقاق أكبر قدر من التعاون والمشاركة وعلاقات حسنة، وتحقيق أهداف تخدم الجميع، لكنّ الحقيقة هي أن الممارسة السياسيّة الداخليّة والخارجيّة خاضعة لشروط الزمان والمكان، ولحسابات القوّة والتوازنات والمصالح الخاصّة،
وبالتالي قد يوافق السياسيّ على أمر يبدو أنه غير صائب من الناحية النظريّة، لصالح نتيجة نهائيّة يدرك هو أنها ستتحقّق جرّاء الظروف السياسيّة، أي أن يقبل بنصّ لا يستسيغه ويتعارض مع قيمه المعلنة، متيّقنًا من أن النتيجة ستكون عكس هذا النصّ، والعكس صحيح. وهذا هو السبب الحقيقيّ للفجوة بين ما يجب أن يكون وفق النظريّة، وما هو موجود عمليًّا. ومن هنا تظهر الفجوة المزمنة بين ما يجب أن يكون نظريًّا وبين الموجود في الواقع العمليّ.
ولا يندر أن يُضحّي السياسيّ بما هو صواب من الناحية النظريّة، لصالح ما هو مناسب وفعّال في ظرف سياسيّ معين، حتى لو تعارض مع القيم المعلنة، مع الإشارة هنا إلى أنّ التوتّر الدائم بين النظريّة والتطبيق في العمل السياسيّ هو جزء لا يتجزّأ من طبيعة السياسة ذاتها. فالسياسيّ لا يسعى إلى المثاليّات التي ذكرها أفلاطون في كتابه المدينة الفاضلة، التي يحكمها فلاسفة وحكماء وملوك يكرّسون حياتهم لخير الدولة، ولا يهتمّون بمصالحهم الشخصيّة، بل العكس فالسياسيّون يهمّهم الحفاظ على السلطة النظام وتحقيق المكاسب الممكنة. أما الصواب السياسيّ فلا يُقاس دائمًا بصحّة النظريّة، بل بملاءمته للظرف الراهن، ولو بدا ذلك نظريًّا موضع جدل أو حتى خطأ.
ما سبق ليس كتابة نظريّة، بل إنه يتعلّق بالتوقيت وهو توقيت جاء بعد أن تيقّن ترامب أنه فشل في وقف إطلاق النار بين روسيا أوكرانيا، وأن الاتفاق في لبنان يواجه عراقيل تمنع تنفيذه، ووسط سخط أميركيّ وأوروبيّ على ترامب لدعمه التامّ لإسرائيل، وسيل الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة وازدياد المعارضة بين الجمهوريّين وخاصّة الشباب لسياسات ترامب، بمعنى أن الخطّة تخدم أولًا ترامب نفسه،
وتقرّبه ربما في نظر ذاته من جائزة نوبل للسلام، كما يتعلّق بما رافق الإعلان عن خطّة ترامب ببنودها وعددها 21 بندًا، وأقصد هنا بالتحديد كونها خطّة خاصّة وشخصيّة وفرديّة، أو فرمانًا ترامبيًّا اطّلعت الدول العربيّة والإسلاميّة على نصّه النظريّ الذي يبشر خيرًا،
ويدعو إلى وقف الحرب والعمل العسكريّ وانسحاب إسرائيل من غزة تدريجيًّا وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليّين ومئات السجناء الأمنيّين الفلسطينيّين، وإعادة للإعمار وضمان الأمن داخل قطاع غزة ورفض أي دور لحركة حماس في فترة ما بعد الحرب، فرحّبت به بنصّه النظريّ، باعتباره يستجيب عاطفيًّا لمواقفها المتضامنة مع الشعب الفلسطينيّ والتي يؤلمها ما لحق به من دمار وما وقع من عشرات آلاف الضحايا وعشرات آلاف المفقودين وتدمير مقوّمات الحياة، لكنّها نسيت استنتاجات كثيرة عبر التاريخ أن النصوص النظريّة كما في هذه الحالة تكون عرضة للتغيير والتبديل إذا لم يتم صبغها بصبغة الاتفاق الرسميّ والتوقيع عليها وفق البروتوكولات الرسميّة، لتصبح ملزمة لا تتغير، ليحدث ما كان عليها أن تتوقّعه وهو أن النصّ النظريّ الذي رحّبت به،
تغيّر وتبدّل وأصبح في بعض جوانبه مختلفًا تمامًا، وأنه بصيغته الفضفاضة ودون جدول زمنيّ واضح وآليّات تنفيذ معروفة وضمانات حقيقيّة سيصبح موضع جدل، وسيمنح كلّ طرف من الأطراف إمكانيّة التملّص والمماطلة والمراوغة.
وهو ما كان أكثر من مرّة في تاريخ الشرق الأوسط، وتكفي الإشارة هنا إلى قرار التقسيم الذي قرأته الدول العربيّة نظريًّا على أنه سيئ فرفضته دون إدراك للظروف المحيطة، رغم أنه كان سيضمن إقامة دولة عربيّة، وكذلك القرار 242 الذي تلا حرب الأيام الستة والذي جاءت صياغته النظريّة مطمئنة للعرب،
وتم فهمها وفق وعود دول العالم، على أنه يفرض الانسحاب من كافّة الأراضي المحتلة، بينما كان النصّ بالفرنسيّة يتحدّث عن انسحاب من مناطق محتلّة، وكذلك اتفاقيّات أوسلو التي فهمها الفلسطينيّون والعرب على أنها بصياغتها النظريّة ، بداية لإقامة كيان فلسطينيّ خلال خمس سنوات، ليتضح أن التطبيق هو الأهمّ، وأنه مرهون بتطوّرات على الأرض وبميزان القوى المتغير. وهو في حالة غزة يميل نحو إسرائيل وبالتالي ستكون لها ربما الكلمة الأخيرة في قضيّة اعتبار التنفيذ كافيًا يستجيب لمصالحها أم لا.. والنتيجة واضحة المعالم اليوم.
ما سبق إعلان الخطّة، يعني أن الدول العربيّة والإسلاميّة والتي تفاوض ترامب معها على هذه الخطة، ويقول البعض أنه أطلعها فقط على شروطها معتبرًا إيّاها نصًّا مقدّسًا، تناست أن هذه الخطّة، هي نسخة ثانية من خطّة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والتي جاءت بعد مفاوضات تمّ فيها استثناء حركة حزب الله، وإعلان اتفاق بين طرفين أحدهما ليس طرفًا في المواجهة العسكريّة التي سبقت الاتفاق، وهو الحكومة اللبنانيّة، والنتيجة خطّة فضفاضة تحدّثت عن بقاء إسرائيل في خمس نقاط في الجنوب، والانسحاب منها خلال شهرين، انسحاب ربطته إسرائيل بسحب سلاح حزب الله، بمعنى أنه اتفاق يلبّي مطالب إسرائيل كلّها، ويبقي مطالب لبنان مرهونة بمواجهة داخليّة لبنانيّة بين الحكومة والسلطة المركزيّة وحركة حزب الله،
وهو بمثابة محاولة فاشلة لتربيع الدائرة، فكيف لحكومة وسلطة لا وجود لها ولا حول إلا بدعم ممثّلي حزب الله في البرلمان، أن تعمل على سحب سلاحه، والنتيجة هي اتّفاق على الورق لم يؤدّ إلى وقف لإطلاق النار، بل إلى عمليّات عسكريّة يوميّة إسرائيليّة في لبنان، فهو لا يقي لبنان شرّ الحرب، بل يؤجّل عودة الحرب إلى حين.
وهو الحال في خطّة ترامب لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد المواجهة العسكريّة بينهما في حزيران الماضي. وهي أيضًا فرمان ترامبي أعاد الطائرات الاسرائيليّة من طريقها لقصف طهران ومنع الصواريخ الإيرانيّة من تهديد إسرائيل، ولكن دون توقيعه رسميًّا، ودون جدول زمنيّ يضمن التنفيذ وإنهاء الخلاف، والنتيجة حديث عن مواجهة عسكريّة جديدة بين الطرفين تكون أقسى وأشدّ، والسؤال فقط موعدها وليس إمكانيّة حدوثها، وفوق ذلك اتفاق إيرانيّ روسيّ ببناء أربعة مفاعلات نوويّة في إيران بتكلفة 25 مليارد دولار، وباختصار خطّتين ترامبيّتين بامتياز، صياغتهما النظريّة تبّشر خيرًا، لكن تطبيقهما على الأرض شبه مستحيل، ما يؤكّد القول أن الطريق إلى جهنم، أي فشل التنفيذ في لبنان ومع ايران وعودة الصدام العسكريّ، مفروش بالنوايا الطيّبة، أي خطّة صيغت بتفاؤل دون آليّات تنفيذ وجدول زمنيّ محدّد، لا تعني درء الخطر، بل تؤجّله فقط.
وفي خضم التفاؤل والفرح بالنصوص النظريّة، وأهمّيّتها القصوى من حيث كونها توقف الحرب والقتل اليوميّ والدمار الشامل الذي يرقى وفق تقارير دوليّة إلى مرتبة عمليّات الإبادة الممنهجة. وهو أمر هامّ في نظري، تجاهل الجميع ربما حقيقة دور الدول العربيّة والإسلاميّة في القضيّة. وأقصد هنا أنها لم تكن الوسيط بين إسرائيل وحماس، كما اعتدنا سابقًا عبر مفاوضات غير مباشر في القاهرة أو الدوحة، بل إنها كانت بمثابة المفاوض وسط غياب تام للفلسطينيّين سواء كان ذلك حركة حماس، أو حتى السلطة الفلسطينيّة، فحماس لم تتلق أي نصّ من هذه الخطّة، بل تلقته فقط بعد موافقة الدول العربيّة والإسلاميّة عليه، وبعد تهليلها وترحيبها به،
قبل أن يقلبه بنيامين نتنياهو ووفده رأسًا على عقب، وسنعود الى ذلك. وهي خطوة شئنا أم أبينا تحمل دلالات تتفاوت بتفاوت موقف من يقولها، فهي في نظر المتفائلين دليل اهتمام عربيّ وإسلاميّ بإنهاء الحرب وهذا مبارك، لكن الغريب في هذا التفسير أنه اهتمام دون وجود من يتم الاهتمام بأمرهم، بينما يعتبره كثيرون أنه نتيجة حتميّة للأوضاع على الأرض واليقين التامّ لدى هذه الدول العربيّة والإسلاميّة، أن حركة حماس، لم تعد قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، وأنها لن تقبل بوقف القتال، أو تقديم تنازلات أيًّا كانت.
وأنها كباقي الحركات الأصوليّة والجهاديّة لا تكترث بمعاناة الناس إذا كانت تلك الطريق نحو تنفيذ توجّهاتها الدينيّة، ففلسطين في نظر حماس، وقف إسلاميّ لا مكان لإسرائيل فيه، ولا تنازل عنه والجهاد لتحقيق ذلك عبر نضال مسلّح هو فرض على الجميع، وهذا يعني سقوط الضحايا والشهداء وقودًا لتحقيق هذا الهدف. وهو توجّه ربما يندرج ضمن توجّهات مشابهة دفعت دولًا عربيّة وخليجيّة بدعم أميركيّ للوقوف ضد أنظمة حكم إسلاميّة أصوليّة تنتمي لحركة الإخوان المسلمين في مصر وتنحية محمد مرسي من رئاسة الجمهوريّة، واستبداله بعبد الفتاح السياسي رئيسًا حتى العام 2034. وهو سبب موقفها الداعم للرئيس التونسيّ الحالي قيس بن سعيد ضد حركة النهضة التونسيّة المنتمية إلى تيار الإخوان المسلمين، وموقفها من الحوثيّين باعتبارهم حركة دينيّة أصوليّة تموّلها ايران، وكذلك حصار قطر عام 2017، لدعمها الحركات الدينيّة الأصوليّة في مصر ولبنان وغزة وسوريا وغيرها. والسبب إيمان الدول العربيّة أن لا إمكانيّة لقبول نظام حكم يستند إلى توجّهات أصوليّة، وأنه انطلاقًا من توجّهاته هذه لا يقبل التفاوض والتنازل أو الاعتدال. ولعلّ أفضل مثال على ذلك هو ترحيب هذه الدول بالرئيس السوريّ الجديد بعد أن تحول من "أبو محمد الجولاني" الداعشيّ ومؤسّس جبهة النصرة ذات التوجّهات الإسلاميّة المتطرّفة ، إلى أحمد الشرع الذي يريد لسوريا انتخابات ديمقراطيّة ومساواة وعودة إلى الإجماع العالميّ، وهو ما تمّ فعلًا، فابتعاده عن توجّهاته الإسلاميّة المتطرّفة، ولو نظريًّا حتى اليوم، كان صكّ الغفران له.
فوق ذلك، ففي هذا التفاوض نيابة عن الفلسطينيّين عودة إلى الماضي السحيق، أي إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل، فالدول العربيّة التي فاوضت حينها وحتى العام 1973 باسم الفلسطينيّين، الذين كانوا بمثابة الحاضر الغائب، لم تفوّت فرصة لتفويت فرصة حصول الفلسطينيّين على حقوقهم أو على الأقلّ محاولة التوجّه إلى المسار السياسي، فهي التي رفضت قرار التقسيم من العام 1947 والذي نص على إقامة دولة عربية على ثلثي فلسطين. وهي التي أصرّت على محاولة إخضاع إسرائيل عسكريًّا وصولًا إلى عام 1967 واحتلال الضفة الغربيّة والقطاع وسيناء والجولان وغور الأردن، الذي استردّ الأردن بعضه باتفاقيّات السلام وادي عربة عام 1994 ،
وفضّلت التشبّث بالأمم المتحدة التي اتّضح أن قراراتها لا تسمن ولا تغني الفلسطينيّين من جوع، بل إنها كرّست معاناتهم ولجوءهم، وهي التي منعتهم من الحصول على كيان، أو حكم ذاتيّ نصّت عليه اتفاقيّات كامب ديفيد، لكنّ الأمر اليوم يتم بتغيير بسيط وهو أن الدول العربيّة ومنذ اتفاقيات أوسلو عام 1993،
والتي كانت عمليّات حماس العسكريّة أحد أسباب فشلها وبعهده سيطرتها على قطاع غزة التي كانت نتيجتها جولات متكرّرة من الصدام العسكريّ مع إسرائيل، وتفضيل للعمل العسكريّ على الاستثمار في الحياة اليوميّة للغزيّين، يساورها الشكّ أن الطرف الفلسطينيّ وخاصّة حماس، ستفوّت كافّة الفرص لوقف الحرب، كما فوّتت السلطة الفلسطينيّة إمكانية السلام وفق معايير كلينتون ( The Clinton Parameters) التي اقترحها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في أعقاب المفاوضات الراكدة بين الإسرائيليّين، بعد الانتفاضة الثانية في أكتوبر 2000 اعتقد كلينتون أنها أفضل ما يمكن في حدود مواقف الطرفين. وكان القصد منها أن تكون أساسًا لمزيد من المفاوضات، وبالتالي لا بدّ من وصاية عليها وتفاوض بالنيابة عنها، بل ربما فرض أمر واقع عليها، تضطرّ لقبوله، حتى لو كان تنفيذه ضرب من المستحيل، فهذه الدول وخاصّة الخليجيّة سئمت كما يبدو تمويل إعادة إعمار غزة مرةً تلو الأخرى، كما حدث منذ العام 2007 .
خطّة ترامب ببنودها وصياغتها الهلاميّة، تؤكّد أن الأهمّ هو التنفيذ، فهي بنود عامّة لا جدول زمنيّ لتنفيذها ولا آليّات وضمانات أيًّا كانت، خاصّة وأنها تتحدّث عن إدارة غزة عبر حكم انتقالّي مؤقّت من قبل لجنة فلسطينيّة تكنوقراطيّة غير سياسيّة، تتولى تقديم الخدمات اليوميّة للسكان، وتتكوّن من فلسطينيّين مؤهّلين وخبراء دوليّين، تحت إشراف هيئة انتقاليّة دوليّة جديدة تُسمى "مجلس السلام"، برئاسة دونالد ترامب، مع شخصيّات وقادة آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطانيّ الأسبق توني بلير، وهو الذي اعترف بأنه خاض حربًا ضد دولة عربيّة وفق معلومات استخباريّة كاذبة، ولم يوقفها رغم إدراكه ذلك،
لتتم مكافأته بعدها برئاسة الرباعيّة الدوليّة للسلام في الشرق الأوسط، وهو من سيذكره التاريخ كواحد من أكثر الذين ألحقوا الضرر بالشرق الأوسط والسلام، دون شرح لآليّة اختيار أفراد هذه السلطة ومن سيختارهم، وهل هي إسرائيل أم اميركا أم طوني بلير، بدعم من قوة أمنيّة عربيّة للحفاظ على الأمن الداخليّ، دون شرح كافٍ لعملها ولدورها في ضمان الأمن الخارجيّ للقطاع. وكذلك الحديث عن سحب سلاح حماس الهجوميّ، وكم بالحري الحديث عن أن لا دور لحماس، أو حتى السلطة الفلسطينيّة في مرحلة ما بعد الحرب، ما سوف يفسح المجال أمام محاولات إسرائيليّة لمواصلة السيطرة على غزة عبر احتلال رماديّ وغير مباشر،
إضافة إلى أن لا حديث عن كيفيّة إعادة الإعمار ومن سينفذها وكيف، فهل هو جاريد كوشنير صهر ترامب المقرّب من السعوديّة والإمارات، أو ويتكوف الابن المقرّب من قطر، ومن سيضمن إعادة إسكان الجميع وإقامة كافّة البنى التحتيّة، يشمل الإعمار بناء مرافق صناعيّة تضمن للغزيّين أماكن عمل وتقيهم الحاجة للاعتماد على الاقتصاد الإسرائيليّ، رغم أنها تتحدث عن أن غزة سوف تلتزم التزامًا كاملًا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلميّ مع جيرانها، دون شرح الآليّة، ودون النظر في واقع غزة التي تعاني الفقر والجوع، وهو أمر في غاية الأهميّة تحتّمه النهاية السلبيّة لاتفاقيّات باريس الاقتصاديّة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة والتي لم تضمن بعد تنفيذها أيّ استقلال اقتصاديّ للضفة الغربيّة، ولم تضمن توجيه أموال الدعم من الدول المانحة لصالح رفاهية المواطنين الفلسطينيّين وتوفير مناطق صناعيّة ومؤسّسات أكاديميّة وتعليميّة ومدنيّة لهم، وفوق هذا فإن خطة ترامب لا تتحدّث عن إقامة كيان فلسطينيّ أيًّا كان، بل تعتبره تطلّع فلسطيني، في تكرار لبنود في اتفاقيّات أبراهام اعتبرت قيام دولة فلسطينيّة تطلّعًا قوميًّا للشعب الفلسطينيّ وليس استحقاقًا دوليًّا.
الخلاصة، هذه الصياغة الهلاميّة تمنح كلّ طرف في المعادلة إمكانيّة التسويف والمماطلة والتهرب والتملّص خاصّة القويّ بينهما، رغم البند الذي ينصّ على أن إسرائيل ملزمة بالانسحاب، وتقديم المعونات الإنسانيّة حتى لو رفضت حماس الخطّة، وهي في نفس الوقت تمكّن حماس من الإشارة إلى إنجازات منها وقف الحرب ووقف نشاطات الهادفة إلى طرد الغزيّين وإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزّة والاستيطان فيه، كما تمكّن إسرائيل من الادّعاء بتحقيق إنجازات منها إعادة المخطوفين واستبعاد حماس والسلطة الفلسطينيّة من مرحلة اليوم التالي، ووجود خطّة أميركيّة توقف الانجراف والتسونامي الدولي المضادّ لإسرائيل والمطالب بدولة فلسطينيّة مستقلّة تضمّ غزة والضفة الغربيّة وشرقيّ القدس. ومن هنا فإن التنفيذ والتطبيق هو الأهمّ، وهو ما سيحدّد ما إذا كانت الخطّة ستؤدّي إلى سلام وهدوء وإلى إقامة كيان فلسطينّي فهي تنصّ على أن الولايات المتحدة ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيّين للاتفاق على أفق سياسيّ لتعايش سلميّ ومزدهر، في عودة إلى مرحلة التفاوض من أجل التفاوض وإدارة الصراع بدًا من، حلّه، أم ستكتفي بجعل قضيّة الحرب في قطاع غزة مسألة إغاثة وتموين بعيدًا عن بعدها الكيانيّ والوطنيّ الفلسطينيّ، وما إذا كان الهدوء سوف يسود أم أنها ستؤدّي إلى تكرار حالة شهدها الصراع، وهي حالة اللا حرب واللا سلام، وهي حالة، بطبيعة الحال، أقرب إلى الحرب والمواجهة، خاصّة مع تجاهلها السياق الأوسع، ويشمل قضية الضفة الغربيّة وسعي إسرائيل إلى ضمّها رغم إعلان ترامب صراحة وعلنًا أنه لن يسمح بضمّها، كما لم تتطرّق إلى قضيّة القدس.
ختامًا هي خطّة تخدم ترامب أوّلًا وتمكّنه من عرض إنجازات كما فعل في قضيتي لبنان وإيران، لكنها عبر ما رافقها وما سبقها تشير، أو تنذر بأن الأطراف المشاركة لم تستنتج العبر اللازمة ، وأنها ما زالت خاصّة العربيّة والإسلاميّة مغرمة بالنصوص المتفائلة التي تخفي أكثر ما تكشف، وربما تضع السمّ موضع الدسم، فتترك المجال لتفسيرات كثيرة حلوها مرّ، تشكّل تهدئة أو فسحة قصيرة من الهدوء ستعود الحرب بعدها. فالانتصارات الجزئيّة خاصّة في القضايا ذات الطابع القوميّ والدينيّ خطيرة، لأنها تعتبر في نفس الوقت هزيمة جزئيّة، وبالتالي كان الأفضل والأجدر أن تتمّ الأمور غير ذلك، وأن يتم تجريب مسيرة أخرى، بعد أن فشلت خطتا ترامب في إيران ولبنان، فهل تستفيق الأطراف كلها بعد حين، وبعد أن يفوت الأوان لتفهم أن ترحيبها بالخطّة كان الخطأ،
أو الاستعجال أو الرغبة لدى سياسيّين في قبول أمر ما يعارض مواقفهم، والاعتماد على أن الغير سوف يتسبّب بالفشل، وأن الحلّ يكمن في مكان آخر وبطريقة أخرى، وذلك بعد فوات الأوان ، بعكس قول الأميركيّ دوج لارسون :"بدلًا من إعطاء السياسيّ مفاتيح المدينة ، قد يكون من الأفضل تغيير الأقفال"، فعرض الخطّة هكذا وما سبقها ورافقها قد يكون في نفس الوقت بادرة خير عامّة، أو مغامرة كبيرة لا ضمان لنتائجها ، سببها غياب للقدرة السياسيّة على رؤية الأمور كما يجب، بخلاف ما قاله ونستون تشرشل: " إن القدرة السياسيّة تكمن في القدرة على التنبّؤ بما سيحدث غدًا، والأسبوع المقبل، والشهر المقبل والعام المقبل. وهي أيضًا القدرة بعد ذلك على شرح سبب عدم حدوث ذلك ". فهل تتوفّر هذه القدرة خاصّة لدى عرَّاب هذه الخطّة؟؟ أم أن كافّة أطرافها تتمتّع فقط بالقدرة على شرح أسباب فشلها وإلقاء اللوم كلّ على غيره؟.