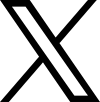الكراهية شرُّ البليّة سياسيًّا وعسكريًّا وداخليًّا وعالميًّا
على الرغم من أنّ الحرب العالميّة الثانية انتهت عمليًّا وميدانيًّا، في مثل هذا الشهر قبل تسعة وسبعين عامًا، باستسلام ألمانيا في الخامس والعشرين من نيسان، وإيطاليا في السابع والعشرين منه عام 1945، فقد شكلَّت بنتائجها ومجرياتها ومنطلقاتها، أي أسبابها المباشرة وغير المباشرة، وبالاستنتاجات والعبر التاريخيّة التي لا يختلف حولها اثنان

الدليل التاريخيّ القاطع، ودرسًا وعبرة واضحة وضوح الشمس لأخطار الكراهية والعنصريّة الإقصائيّة العرقيّة والدينيّة والفكريّة، وخاصّة أخطار تحوّل الكراهية إلى أساس تبنى عليه البرامج السياسيّة للأحزاب المختلفة، وأخطر من ذلك سياسات الدول كلّها، سواء كانت الخارجيّة تجاه جاراتها القريبة، والدول البعيدة، بمعنى اعتماد الكراهية على أساس دينيّ وعرقيّ وسياسيّ، مقياسًا لمدى العداء ونوعيّته ومدّته ووتيرته،
أو داخليًّا بمعنى اعتبار المعايير العرقيّة والدينيّة والسياسيّة، وأحيانًا الاجتماعيّة والفكريّة، المقياس الوحيد لتحديد الموقف من الأقليّات خاصّة، والفئات المختلفة فكريًّا وسياسيًّا عامّة، وبالتالي كانت حالة لم تتكرّر أوروبيًّا حتى اليوم، ربما باستثناء بسيط وهو الحرب الأهليّة في يوغسلافيا في تسعينات القرن الماضي، التي غذّتها الكراهية الدينيّة، أو التزمّت الدينيّ، الذي شكَّل الأساس الذي بنيَت وفقه القوى وصيغت الجهات التي خاضت الحرب ووفقه تمّت نهاية الحرب بدول تمتاز كلّ منها بطابع دينيّ خاصّ.
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط والتي بصنيع أيدي أبنائها وزعاماتها خدمة لمصالحهم الضيّقة والشخصيّة، أو لأهداف تخدم جهات خارجيّة من جهة، أو صنيع جهات خارجيّة استخدمت جهات داخليّة، أو نصّبت زعامات داخليّة لضمان أهدافها ومصالحها المستقبليّة، والأمثلة كثيرة وعديدة، ما زالت تشهد عدم الهدوء والاستقرار السياسيّ والسلطويّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، لم تتعلّم العبر التاريخيّة من تلك الحرب التي أوقعت ملايين الضحايا من كافّة الدول، بل إنها وخاصّة بعض دولها وجماعاتها، تصرّ على جعل الكراهية العامل والأساس الذي تبني عليها سياساتها الخارجيّة والداخليّة دون استثناء،
وبالتالي يمكن الجزم أن معظم المجتمعات في منطقتنا، وبتفاوت طبيعيّ، هي مجتمعات تسيطر عليها الكراهية، وتتحكّم بها بشكل أو بآخر، وأنها فتكت ببعضها ودمّرتها، وبالتالي حوَّلتها إلى مجتمعات ودول غير قادرة على بناء مستقبلها، والدليل على ذلك هو نتائج الربيع العربيّ الذي لم تحرّكه ولم تغذّيه اختلافات الرأي والخلافات السياسيّة والأيديولوجيّة، بل كراهية الغير ومحاولة إقصائه بسبب انتمائه الدينيّ،
أو السياسيّ، أو العرقيّ، بل أكثر من ذلك فقد جعلت الكراهية، وهذا الأخطر فيها، تلك الدول والمجتمعات بعيدة عن السلام الداخليّ، أو السلام مع نفسها، ومظاهر ذلك أن معظم الدول والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط، وإسرائيل منها خاصّة في الأعوام الأخيرة، غير قادرة أو أنها ترفض عمدًا ومع سبق الإصرار والترصّد عدم انتهاج التعدديّة وقبول مظاهرها الداخليّة، عبر كراهية تصنع صنعًا وتغذيها مصالح سياسيّة واقتصاديّة فئوية وفوق ذلك وسائل إعلام نسيت أنها الحارس للديمقراطيّة والسلطة الرابعة، وتحوّلت إلى إعلام يضرب بسوط السلطان ويكرّس كراهيته والسياسات المنبثقة عنها في كافّة دول المنطقة دون استثناء، وإذا كان الحال كذلك داخليًّا في كافّة دول المنطقة فإنه ينسحب أيضًا على السياسات الخارجيّة للدول، في العقود الأخيرة.
قبل الخوض في التفاصيل، والأمثلة الكثيرة القريبة منها والبعيدة التي تؤكّد أن الكراهية الداخليّة والخارجيّة، أصبحت وللأسف السمة السائدة للمجتمعات والدول في الشرق الأوسط. وهي منطقة يحلو لقادتها وشعوبها عامّة ترديد وتصديق نظريّات المؤامرة، أي تحميل الأيادي الخارجيّة مسؤوليّة كلّ سوء يلحق بهذه المجتمعات والدول، سواء كانت هذه الأيادي تسمّى الرأسماليّة، أو الإمبرياليّة، أو الشيوعيّة،
أو الصهيونيّة، أو العلمانيّة وغيرها، لا بدّ من تأكيد المؤكّد بما لا يقبل الشكّ في علوم الاجتماع والسياسة، من أن تطوّر وتفاقم وسيطرة مظاهر الكراهية في مختلف المجتمعات والدول، أو تلك الظاهرة التي تسمّى بكافّة مركّباتها وجوانبها وتبعاتها بصناعة الكراهية، هي ظاهرة داخليّة بحتة وخطواتها، أو تسلسلها واضح ومعروف، فهي تبدأ أوّلًا ، باختيار الضحيّة، أي اختيار "عنوان الكراهية" الداخليّ، سواء كانت تلك مجموعة دينيّة، أو عرقيّة، أو سياسيّة،
أو فكريّة، ووصفها، أو وصمها، أو اعتبارها مجموعة وكتلة واحدة لا خلافات، ولا تنوع ولا اختلافات داخلها، كالتعميم والقول مثلًا العرب داخل إسرائيل، أو الفلسطينيّون، أو الشيعة أو الدروز في بلاد مسلمة سنيّة، أو السنّة في إيران، والمسيحيّون في لبنان رغم تنوّعهم واختلاف مواقفهم ومنطلقاتهم، أو المسيحيّون في مناطق السلطة الفلسطينيّة، وغيرهم، بمعنى جعلهم مجموعة مُتَصَوَّرة وفق تعريف علم الاجتماع، ما يسهِّل عمليّة كراهيتهم بشكل مطلق، فكلهم سيَّان ومن نفس الطينة، وبالتالي فهو تعريف يجنّب الطرف الكارِه، شرّ التفكير وضرورة التعامل مع الفروقات والاختلاف، وتناسي التفاصيل الصغيرة التي تتضافر لتشكّل الصورة الكاملة،
وتجاهل الحقيقة بأن ليس هناك مجموعة ما من الناس تتشابه في كلّ شيء، وهو تجاهل مقصود، فادّعاء التشابه بين أفراد المجموعة التي تطالها الكراهية، هو عامل مهمّ لصناعة الكراهية، فالقول أن السود في أمريكا يفكّرون بنفس الطريقة، أو القول أن الشيوعيّين يسلكون كلّهم نفس السلوك، أو أن العرب كلّهم أعداء للدولة وطابور خامس، كما يقال هنا في بلادنا، هو الخطوة الأهمّ والأولى، بل التي تشرعن وتسوِّغ نزع الشرعيّة، عن المجموعة، وبالتالي تتيح أو تقبل كيل الاتهامات لهذه المجموعة، واعتبارها مصدر كافّة الشرّ والمصائب، وتحميلها مسؤوليّة كلّ ضرر يلحق بالمجتمع ومصدر كلّ الشرور،
وأساس كلّ ضرر يحلّ بالمجتمع، أو أنها تهديد لسلامة المجتمع ونقائه العرقيّ( أقليّة عرقيّة عربيّة في دولة يهوديّة)، ولذلك فهي تستحق الكراهية. كما حصل مع اليهود في ألمانيا قبيل الحرب العالميّة الثانية، أو اتهام هذه المجموعة، وبسبب مواقفها السياسيّة والإيديولوجيّة، بالخيانة ومحاولة زعزعة الحكم، كما يحدث في بعض الدول العربيّة تحت مسمّيات محاولات العبث بالأمن المجتمعيّ،
أو المسّ بالحكّام وزعزعة الاستقرار، أو في إقليم الأحواز الإيرانيّ ذات الأقليّة السنيّة، واتهام كافّة معارضي حرب فيتنام في أمريكا بأنهم عملاء سوفييت، أو اليساريّين في إسرائيل بأنهم خونة يفضّلون مصلحة الفلسطينيّين على مصلحة إسرائيل. وإمعانًا في كلّ ما سبق يتمّ إضفاء صفات حيوانيّة على المجموعة، ويكفي أن نذكر مثلًا الوصف الذي الصقه أبناء قبيلة "الهوتي" في رواندا بمجموعة "التوتسي" بأنهم صراصير، واستخدام النازييّن عبارات ورسومات تصوَّر اليهود بشكل مشين، ووصف اليهود اليوم بأنهم أبناء قردة وخنازير، أو الفلسطينيّين في غزة بأنهم حيوانات بشريّة، أو اللاجئين السوريّين في لبنان بأنهم يستولون على مصادر رزق اللبنانييّن الأصليّين، أو المسيحيّين في عرف "داعش" التي تعتبرهم من الكفار، وتحاول فرض الديانة الإسلاميّة عليهم وإلا فجزاؤهم الموت، وغيرها وغيرها، علمًا أن استخدام هذه الصفات ونزع إنسانيّة المكروه، تجعل النتائج غير هامّة، أو بالأحرى تصرف النطر عن النتائج، ولتكن مأساويّة مهما كانت، على المكروه خاصّة وحتى على الطرف الذي يمارس الكراهية ويستخدمها أساسًا لسياسته.
أقول ما سبق، وأستذكر المآسي التي عاشها الشرق الأوسط في العقود الأخيرة ، أو ربما سيعيشها جرّاء صناعة الكراهية السائدة، أو القلاقل التي يمكن أن يعيشها، جرّاء ذلك، وأستشهد بما حدث هذا الأسبوع من إطلاق لمئات الصواريخ والطائرات المسيَّرة الإيرانيّة تجاه الأراضي الإسرائيليّة.
وهي عمليّة ثبت بالدليل القاطع فشلها عسكريًّا واستراتيجيًّا، لكن هذا ليس المهمّ هنا، بل إن المهمّ أن صناعة الكراهية التي تنتهجها إيران خاصّة منذ العام 1978، أي منذ الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، واستيلاء الإمام الخميني العائد من منفاه في باريس، على مقاليد الحكم، والنحو باتجاه دولة الفقيه، وتصدير الثورة الإسلاميّة بصيغتها الإيرانيّة الشيعيّة، التي تعتبر المختلف عدوًّا يجب إخضاعه والسيطرة عليه، وصولًا إلى إعادة تأسيس الإمبراطوريّة الفارسيّة، التي سيطرت على الخليج وغيره طيلة سنوات،
وهي طموحات وتوجّهات، أو صناعة كراهية، كانت أحد أسباب نشوب وإطالة أمد الحرب مع العراق السنيّ، والتي بدأت عام 1980 دامت 8 سنوات، وكان أحد دوافعها خوف العراق من الهيمنة الشيعيّة الإيرانيّة بعد استيلاء الخميني، وانتهاج إيران سياسة تعتمد كراهية المختلف سواء كان مسلمًا سنيًّا، ومن هنا عداؤها للدول السنيّة الخليجيّة، وإقامتها جماعات مسلّحة منها فيلق القدس وحزب الله والحوثيّين،
للسيطرة على دول مسلمة سنيّة، تمامًا كما محاولات استغلال إيران للمناسبات الدينيّة، لتنفيذ هجمات في السعوديّة، وصلت ذروتها عام 1986 حين نظَّم الإيرانيّون مظاهرة تم خلالها رفع شعارات سياسيّة، أدّت إلى اشتباكات مع الأمن السعوديّ، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص من الحجاج وقوّات الأمن، وانفجارا عام 1989 قرب الحرم، واللذان تم اعتقال كويتيين ينتمون إلى تنظيم إيرانيّ بتهمة تنفيذهما، وغير ذلك،
أو إذا كنت يهوديًّا تؤكد إيران رغبتها ضمن مبدئها الشيعيّ، رغبتها في إلحاق الضرر بدولتك، أو حتى إبادتها كما أعلن رئيس حكومتها محمد أحمدي نجاد من على منصّة الأمم المتحدة، وبالتالي تعدّ لذلك أسلحة نوويّة كمركّب أساسيّ لصناعة الكراهية، التي تزيح النظر، أو تتعامى عن النتائج والعواقب والأضرار التي ستلحق بشعبها هي جرّاء ذلك، والتي تجلّت عبر انخفاض مخيف في المستوى الاقتصاديّ، وتدهور التعليم والشلل في مرافق الحياة والعجز حتى عن تصنيع النفط الذي تنتجه، فكلّ المقدّرات مسخَّرة لخدمة صناعة الكراهية، والحديث عن الشيطان الأكبر والأصغر، الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي فالغاية تبرّر الوسيلة.
أما التبعات فلا وزن لها، وهذا ما حصل هذا الأسبوع أيضًا، فالهجوم الإيراني لم يغيّر من الواقع بينها وبين إسرائيل شيئًا، ولم يصبّ في مصلحة الحرب في غزة بمعنى أنه لم يؤدِّ إلى وقفها، أو انسحاب إسرائيل من غزة، ناهيك عن الثمن الاقتصاديّ الكبير والعودة إلى عهد أرادت إيران أن تنساه، وهو عهد العزلة الدوليّة خاصّة وأنه أدّى إلى نتائج إيجابيّة للغاية في حسابات إسرائيل، فالائتلاف الفوريّ الذي صدّ الهجمات، وشاركت فيه الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة ودول خليجيّة والأردن الذي وجد نفسه وسط معمعة لا ناقة له فيها ولا جمل، بل زجّت به إيران داخلها دون جريرة، إضافة إلى الفشل العسكريّ الواضح، أدّت بقدرة قادر،
وربما كجزء من مسرحيّة مدروسة كانت فصولها المتأخّرة واضحة منذ الفصل الأوّل، عبر معرفة إسرائيل بعدد المسيَّرات التي أطلقتها إيران وموعد وصولها ووجهتها وكذلك الصواريخ، وبالتالي انتظرتها وتأهّبت لوصولها " واستقبالها على أحسن وجه"، ساهمت في إخراج إسرائيل من عزلتها، وأصبح بنيامين نتنياهو الذي كان محاصَرًا ويعاني الإقصاء والرفض من قبل زعماء الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة والدول العربيّة،
وخاصّة الخليجيّة والأردن، ومطالبًا بوقف الحرب فورًا في قطاع غزة، أصبح زعيمًا ينشد الجميع ودّه ويرجوه الاكتفاء بردّ عقلانيّ ومختصَر على الهجوم الإيرانيّ. وهذا نقيض تامّ لما كان قبل الهجوم من حيث تعرّضه الدائم للانتقادات والتهديد بقطع الإمدادات العسكريّة، التي تحوّلت إلى تأييد تامّ ومساعدة واستعداد للدفاع مجدّدًا عن أمن إسرائيل، فهجوم إيران كجزء من صناعة الكراهية تجاه إسرائيل،
أعاد لإسرائيل ونتنياهو الزخم والدعم خارجيًّا، أما داخليًّا فقد أعاده الهجوم إلى موقف القائد الذي يؤيّده الكثيرون ويتّفق معه معظم زعماء المعارضة، وذلك بعد أشهر من اتهامات من كلّ حدب وصوب، بأنه المسؤول عن أحداث السابع من أكتوبر ونحو ألف وخمسمئة ضحيّة ومئات المحتجزين، والذين ما زال نحو 130 منهم في القطاع رغم مرور سبعة أشهر تقريبًا، والمسؤول عن غوص الجيش في حرب لم ينجح فيها في هزيمة "حماس" بمسلّحيها الذين يبلغ عددهم نحو 30 ألفًا فقط وسط ميزان قوّة عسكريّة ترجح فيه كفّة إسرائيل أضعافًا مضاعفة، ومطالبات بتنحيه والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وهو سيحاول اليوم استغلال هذا الهجوم لتحقيق مكاسب سياسيّة شخصيّة تضمن بقاءه في السلطة وعلى سدّة الحكم، لأطول فترة ممكنة، وهو نفس الهدف الذي تريد القيادة الإيرانيّة تحقيقه أي البقاء في السلطة عبر ترسيخ خطاب الكراهية، والتركيز على الغاية دون الثمن الذي تكلفه الوسيلة، أو التضحية بكلّ شيء من أجل تحقيق غاية، ربما تعرف أنها غير قابلة للتحقيق لكنها تشكّل وسيلة لتخدير العامّة وضمان صمتهم، عن طيب خاطر أو عنوة.
والشيء بالشيء يذكر فخطاب الكراهية، أو صناعة الكراهية، التي تعتمد شيطنة الآخر ونزع الصفة الإنسانيّة عنه، بل هدر دمه وإباحة قتله وغير ذلك، كانت السبب وراء السابع من أكتوبر وما تلاه حتى اليوم، فإسرائيل بالنسبة لمسلّحي "حماس" وقف إسلاميّ يجب استرجاعه وطرد اليهود منه، إلا من طلب الصفح والتوبة والغفران، وهو هدف سامٍ يجب تحقيقه، أو محاولة تحقيقه مهما كلّف ذلك من ثمن، حتى لو كان الثمن هدم القطاع كاملًا على رؤوس مواطنيه، فالأهداف الجسام، بالنسبة لميثاق "حماس" ،
تستحق التضحيّات حتى لو تعبت في مرادها الدنيا بكاملها، ومن هنا ورغم النتائج المأساويّة للحرب الدائرة منذئذٍ، تصرّ قيادة "حماس" على تصوير الأمر على أنه إنجاز يستحقّ التضحيّات، وأنه عمل ألحق بإسرائيل هزيمة نكراء كادت "حماس" تحقّق هدفها النهائيّ من ورائه، وهو الأمر بالنسبة للردّ الإسرائيليّ الذي اعتمد "خطاب الكراهية"، عبر وصف كافّة الفلسطينيين عامّة وفي القطاع خاصّة، بالحيوانات البشريّة أو النازيّين، ما كان القصد منه نزع شرعيّتهم وليس ذلك فحسب، بل شرعنة وإباحة المسّ بهم دون حساب أو عقاب،
فهم وفق الوصف فئة دونيّة أقل قدرًا وقيَمًا وقيمةً من الغرب وإسرائيل، ما سيصعب من وقوف العالم إلى جانبهم، وهو ما كان حتى قبل عدة أسابيع عبر دعم دائم ومتواصل وغير مشروط عسكريًّا وسياسيًّا، وسط تجاهل شبه تامّ لسقوط أكثر من 33000 قتيل فلسطينيّ غالبيّتهم الساحقة من النساء والأطفال والمدنيّين، وفق اعترافات إسرائيليّة تؤكّد أن نحو 9000 منهم فقط هم من المسلّحين، وهي حالة تنسحب أيضًا على الحال في الضفة الغربيّة والسلطة الفلسطينيّة، فصناعة الكراهية تتعمّد التعميم والجَمعِيّة بدل الاهتمام بالفرديّة، ومن هنا ربما الصمت ليس فقط عالميًّا، بل إسرائيليًّا داخليًّا وإعلاميًّا على ما يحدث، والدليل أن استوديوهات التلفزة بموجاتها المفتوحة لا تمنح أيّ مساحة لمن يحاول زعزعة وتقويض، أو حتى مناقشة صناعة الكراهية ونتائجها. ومن هنا لم يجد أيّ من المعلّقين، أو المحلّلين أو الصحفيّين الإسرائيليّين الشجاعة المهنيّة والجرأة الأخلاقيّة، لمناقشة ولو بسيطة لأهداف الحرب في غزة ومخرجاتها ومجرياتها وخاصّة المسّ بالمدنيّين، بل إن جميعهم صمتوا صمت أهل القبور، فالفلسطينيّون واحد وكلّهم يستحقّون ما سيحصل لهم، ولا يحقّ لأحد الدفاع عنهم.
والأمر سيّان على الساحة السياسيّة الإسرائيليّة خلال الأعوام الأخيرة خاصّة والعقد الأخير عامّة، فصناعة الكراهية هي السائدة، إذ أصبح التعميم سيّد الموقف، فاليسار في نظر أنصار الحكومات الليكوديّة واليمينيّة المتعاقبة، خائن ومتهاون ومتهادن، يحب الفلسطينيّين ويكره أرض إسرائيل وتوراتها، وينحني خضوعًا للإرهاب والأعداء ويتنازل عن هويّته وهيبته اليهوديّة، أما من يطالب بإنهاء الاحتلال فهو ضعيف وساذج يعمل لمصلحة الغير، ومن ينادي بإنهاء الحرب في غزة حاليًّا باعتبارها لن تصل حدّ النصر المطلق،
كما يقول نتنياهو، هو فوضويّ ومتآمر يتساوق مع مواقف وطروحات إدارة جو بايدن ،ومتظاهر يحقّ للشرطة اعتقاله والاعتداء عليه، ناهيك عن أن المطالبين باستقالة بنيامين نتنياهو لمسؤوليّته عن نتائج السابع من أكتوبر وما سبقها من ضعضعة للحمة الداخليّة بسبب الانقلاب القضائيّ، يوصفون بأنهم عامل هدَّام يريد إضعاف وزعزعة صمود إسرائيل ومتانتها ومناعتها، أما معارضو الانقلاب الدستوريّ، فهم مجموعة تحرّكها الفوقيّة العرقيّة والرغبة في السيطرة من قبل اليهود الأوروبيّين على حساب اليهود من أصل شرقيّ،
والعكس صحيح، فمؤيّدو اليمين في نظر المعارضين لهم، هم قطيع أعمى يعبد نتنياهو ويصلي له، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الشفافية والنزاهة والقدرة والعلم، والسعي إلى تغيير في الدستور والقضاء هو محاولة انقلاب ورغبة في السيطرة على جهاز القضاء وإفساد القطاع العامّ. أما المواطنون العرب في البلاد، فصناعة الكراهية تجعلهم في حالة الانقلاب القضائيّ، خارج اللعبة فالعدالة بالنسبة لهم لن تتمّ ما دام النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ قائمً،ا كما تجعلهم خارج الصورة حتى عندما يتعلّق الأمر بالاحتجاجات، فهي بالنسبة لليهود ليست سياسيّة، بل حقوقيّة. وهو فصل لا يمكن للعربيّ في إسرائيل فعله وقبوله، فقرارات الحكومة وتشريعاتها حتى الحقوقيّة المتعلّقة به،
سياسيّة بامتياز وقانونا القوميّة ولمّ الشمل أكبر دليل على ذلك، وكذلك قانون كمينيتس، الذي لا ينكر أحد أنه جاء لمنطلقات سياسيّة، وقرار الحكومة الأخير نقل صلاحية إنفاذ قانون الهدم ضمن سلطات التخطيط والبناء من وزارة المالية حيث هو منذ الأزل، إلى وزارة الأمن الداخليّ برئاسة الوزير إيتمار بن غفير المعروف بعدائه وكراهيته للعرب، وغير ذلك من الخطوات الحكوميّة، ومنها تلك المتعلّقة برفض توسيع مناطق نفوذ بلدات عربيّة، كانت حكومة سابقة أو لجنة عيّنتها حكومة سابقة بتوسيع نفوذها كبلديّة سخنين مثلًا، ورفض نقل ميزانيّات للسلطات المحليّة العربيّة، وهي حقّ مدنيّ، لأسباب سياسيّة، ومثله إلغاء كافّة خطط مكافحة العنف في المجتمع العربيّ والذي يسجّل أرقامًا قياسيّة في عدد ضحايا العنف. وهو هنا في هذا المجال مجتمع تحرّكه صناعة الكراهية الداخليّة.
صناعة الكراهية إذن، قرار داخليّ تتّخذه الحكومات والسلطات، ويمكنها وقفه وإنهاؤه إذا ما أرادت، وتأكيدٌ لذلك تجيء به الذكرى السبعون (تحلّ الشهر القادم) لقرار المحكمة العليا الأمريكيّة من السابع عشر من أيار عام 1954، حيث اتّخذت المحكمة بالإجماع قرارًا هامًّا، بل شكَّل بداية النهاية، تصريحيًّا على الأقلّ حينها، لصناعة الكراهية في الولايات المتحدة، والتي بلغت ذروتها عبر نظام الفصل العرقيّ،
جاء فيه بأن الفصل في المدارس على أساس العرق ينتهك الدستور الأميركيّ الذي يضمن الحماية المتساوية بموجب القانون، علمًا أن هذا القرار التاريخيّ، والذي عرف بالتماس براون ضد مجلس التعليم، شكّل محفّزًا للحركة الاحتجاجيّة المدنيّة التي طالبت بإنهاء الفصل العرقيّ والمساواة في الحقوق في الولايات المتحدة، أي إلغاء "صناعة الكراهية" التي سادت منذ عام 1896 وأجازت الفصل في المرافق العامّة بين البيض والأميركيين الأفارقة،
ومن هنا فإن القرار في قضية براون، قوَّض الأساس القانونيّ للفصل العنصريّ، ليس في المدارس والجامعات فحسب، بل وأيضًا في السكن والمواصلات(قضيّة السيدة روزا باكس) والأماكن العامّة، والبداية كانت قبول تسعة طلاب أفارقة عُرفوا باسم " التسعة من ليتل روك" في المدرسة الثانويّة المركزيّة في مدينة ليتل روك، بولاية أركنسو، مع الإشارة إلى أنه استغرق الأمر حتى ستينيات القرن العشرين حتى ألغي الفصل العرقيّ تمامًا في المدارس الأميركيّة عبر عمليّة التحرير( Emancipation ).
وهو الدليل على أن صناعة الكراهية تمامًا مثل إنهائها إنما هي قرار داخليّ سياسيّ، تحرّكه مصلحة السلطات والنظام والقيادات، وهي حقيقة تثير في آنٍ واحدٍ معًا التفاؤل والخوف، تفاؤل مصدره أنها ليست حالة دائمة، بل متغيّرة، وبالتالي يمكن أن تنتهي بقرار سياسيّ، والخوف من أنها قرار سياسيّ يجب أن يتحلّى من يريد إلغاءه بالشجاعة والمسؤوليّة والأخلاق. وهي صفات قلّما تواجدت في صفوف السياسيّين، عملًا بقول العالم المشهور في علم الاجتماع السياسيّ ماكس ويبر، المتعلّق بالأخلاق والمسؤوليّة، إذ يقول إن هذا الاقتران لا يشمل السياسيّين اليوم، بل إن تنفيذه يتطلّب اقتصار السياسيّين على الطابع الوظائفيّ فقط.
في الوقت ذاته، يبقى الأمل في أن نهاية صناعة الكراهية ممكنة، وربما من نفس صانعيها، عملًا بقول محرّر جنوب أفريقيا المناضل نلسون مانديلا:" لا يوجد إنسان ولد يكره إنسانًا آخر بسبب لون بشرته، أو أصله أو دينه. الناس تعلّمت الكراهية، وإذا كان بالإمكان تعليمهم الكراهية، إذاً بإمكاننا تعليمهم الحب، خاصّة أن الحب أقرب إلى قلب الإنسان من الكراهية".