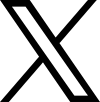متى ستحكم الشعوب قيادات حكيمة وعقلانيّة وليست غوغائيّة هشّة؟
بخلاف السائد في شرقنا، في معظم الحالات عامّة، وفي زمن الأزمات والشدائد خاّصة، وبين الجميع بمن فيهم بعض أولئك الذين يطيب لهم تسمية أنفسهم بالمثقّفين والمفكّرين والقياديّين، الذين يستخدمون التاريخ بأحداثه ومجرياته وتعرّجاته ، مكانًا يعود الجميع إليه هربًا من الواقع الأليم، والحاضر التعس الذي يعيشه الشرق.

أو موقعًا يشكّل الركون إلى الأطلال فيه، متنفّسًا إزاء حالة الضعف والعجز خاّصة في العالمين: العربيّ والإسلاميّ. وهي حقيقة واقعة لا بدّ من الاعتراف بها، ليس جلدًا للذات، بل محاسبة لها، ومحاولة لتغيير مجرى الحياة، وتعديل الأمور إلى مسارها الصحيح، أو البدء بذلك على الأقلّ، أؤكد هنا، وإنصافًا للحقيقة الأكاديميّة والعلميّة، ضرورة وأهميّة دراسة التاريخ والعودة إليه، شرط توظيفه في مكانه الصحيح،
واعتباره تمامًا كما يجب أن يكون، أي النظر إليه على أنه دروس سابقة وماضية، وتجارب وحالات تفيدنا دراستها مستقبلًا، وتشكّل مقدّمةً للتخطيط المستقبليّ، والاستفادة من عبر التاريخ، ومنعطفاته، ومن معرفة ودراسة سيرة ومسيرة الحضارات السابقة، وعوامل فشلها وضعفها، تمامًا كما عوامل ازدهارها وتقدّمها ونهضتها ، وبالتالي أسباب بقائها ودوامها، وربما أسباب دمارها وزوالها، ومن باب الإيمان أن دراسة واعية للتاريخ عمادُها الرغبة الصادقة والمدروسة في استخلاص العبر والدروس اللازمة والواعية والعقلانيّة، على مستوى الشعوب والقيادات، خاصّة تلك المتعلّقة بالعلاقات بين الدول والشعوب، وتلك التي تحملها الأزمات والحروب وتصرّف القيادات خلالها، فإننا بذلك نختصر على أنفسنا العديد من التجارب، ونتحاشى الوقوع في أخطاء السابقين ،
ما يعني تمكين الشعوب من المضي قدمًا، وبخطى واثقة وقرارات صائبة، أساسها الجزم بأن علم التاريخ كباقي العلوم يستند على حقائق ووقائع وبينات علميّة ثابتة، وصورة دقيقة وواضحة عن والتجارب التي مرَّ بها الإنسان، وبالتالي تكون هذهِ الدراسة بابًا، لتجنّب ما وقعَ بهِ السلف من أخطاء جرت عليهم وعلى شعوبهم الويلات والدمار. ولكن، يبدو واضحًا للعيان اليوم أن القيادات لم تستخلص من التاريخ العبر، حتى ولو كانت أحداثه وويلاته كبيرة وهائلة وعظيمة وفتّاكة، ومنها الحربان العالميتان الأولى والثانية من جهة،
ومحاكم التفتيش وقمع الحريات والتمييز ضدّ الأقليّات العرقيّة والدينيّة والسياسيّة من جهة أخرى، أو قضية الحروب في مختلف بقاع العالم خاصّة الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا، وحرب روسيا على أوكرانيا أيضًا، وكلّها حروب أنتجت موجات من تدفّق اللاجئين باتجاه الدول الأوروبيّة التي رحَّبت بعضها بأفواج اللاجئين، بينما أغلقت بعضها الأبواب، أو تحاول ذلك ومنها إيطاليا وغيرها، أو تلك الاستنتاجات التي تتعلّق بالقيادات، وكيف يخلّدها أو يذكرها التاريخ، بمعنى كيف سيذكر التاريخ القيادات، وهل سيذكرها لكونها قيادات شجاعة حملت رسائل إنسانيّة وحضاريّة وديمقراطيّة، ورسالة سلام وتعايش وانفتاح حضاريّ وثقافيّ عادت بالفائدة على شعوبها خاصّة،
وربما العالم عامّة، أو قيادات بذلت جلّ جهدها في كبت شعوبها وإسكات صوت معارضيها، وتقزيم الديمقراطيّة والجهاز القضائيّ داخليًّا، واستخدام القوة العسكريّة والاقتصاديّة ضد خصوم حقيقيّين، أو محتملين وربما وهميّين خارجيًّا، وهي حالة تثير كل مرة من جديد السؤال حول ما إذا كانت القوة والسلطة تثير لدى البعض نشوة التسلّط والخراب والانتقام، وتؤدّي رغبة التمسّك بها إلى تصرّفات، أقلّ ما يقال فيها، إنها هدّامة، منها على سبيل المثال محاولة خلق وقائع على الأرض سواء عبر الترحيل و التهجير، أو ما يحلو للبعض اليوم تسميته بإعادة التوطين.
أقول ما سبق على ضوء ثلاثة أحداث تتزامن معًا، يؤثّر كل منها على العالم بأسره، وليس على إقليم واحد، أو منطقة واحدة دون غيرها، أولها انتخابات الرئاسة الأميركيّة التي بدأت على صعيد الولايات المختلفة عبر انتخابات تمهيديّة تصل ذروتها في تشرين الثاني القادم، وتدور رحاها بين الرئيس الحالي جو بايدن الديمقراطيّ، والذي يعتبره كثيرون بطّة عرجاء تفقد بشكل متواصل ومستمر تأييدها وشعبيّتها خاصّة في أوساط معيّنة ، وذلك جرّاء تحقيقات حول وثائق تم العثور عليها في منزله بعد أن انهى مهامّ منصبه نائبًا للرئيس باراك أوباما قبل ثمانية أعوام، ناهيك عن موقفه من الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة خمسة أشهر،
وما خلّفته من دمار وخراب وضحايا في الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ على حدّ سواء، ومرشّح آخر هو الرئيس السابق الجمهوريّ دونالد ترامب، الذي يخوض الحملة الانتخابيّة وسط غمامة قاتمة من لوائح الاتهام والتحقيقات المتواصلة من جهة، والغرامات الماليّة الباهظة بمئات ملايين الدولارات من جهة أخرى، واتهامات بخرق القانون ومحاولة الانقلاب على انتخابات عام 2020، وتحديدًا السادس من ينايرعام 2021 في الكابيتول، والثانية استمرار الحرب في غزة، وما يرافقها من حديث متزايد خاصّة مع اقتراب موعد العمليّة البريّة الإسرائيليّة في رفح، عن إعادة توطين الغزيّين في شبه جزيرة سيناء،
أو في مناطق أخرى في الشرق الأوسط والعالم ومطالبة الدول الأوروبيّة للمشاركة في ذلك، على ضوء ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وخاصّة العالميّة والأوروبيّة والعربيّة من تفاصيل حول سوء الأوضاع الإنسانيّة والصحيّة والعامّة في القطاع، تزامنًا مع ارتفاع الأصوات في إسرائيل الداعية إلى هجرة طوعيّة، أو ترحيل طوعيّ للمواطنين الغزيين، والتأكيد على الرفض المصريّ والعربيّ والفلسطينيّ والأوروبيّ، بل العالمي لذلك، خاصّة على ضوء قضيّة الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وملايين المهاجرين إلى أوروبا، والثالثة هي الحال في قطاع غزة بعد الحرب أو بعد نهايتها، والسؤال ما إذا كانت القيادات هناك عامّة وحركة "حماس" خاصّة قد استخلصت العبر اللازمة والصحيحة من الحرب الحاليّة، ومن مجريات الأحداث منذ العام 2007 أي منذ استيلاء الحركة على السلطة في القطاع،
وطرد السلطة الفلسطينيّة من مواقع السيطرة والتأثير، وبشكل خاصّ الجزئيّة المتعلّقة بكيفيّة استغلالها، أو استخدامها للسلطة، بعد أن اتضح أنها استخدمت السلطة فقط لمصالحها الضيّقة، وليس لمصلحة مواطنيها ورفاهيتهم وتحسين جودة حياتهم، وفتح آفاق الحياة أمامهم بدلًا من تجيير الميزانيّات والأموال والمقدرات والثروات لأهداف عسكريّة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالحياة اليومية للناس هناك من جهة، واستخدام القوة والسلطة لقمع المعارضة والمعارضين الداخليّين، وكبت كلّ فكر مختلف يبتعد عن الفكر الإسلاميّ المتزمّت والأصوليّ.
لم يكن إدراج الانتخابات الأميركيّة في المكان الأوّل عبثًا، بل إنه حاجة وضرورة تفرضها الحقيقة العقلانيّة التي تعترف بأن الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، خاصّة في ظلّ حالة القطب الواحد، أو الدولة العظمى الوحيدة في العالم سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، وبالتالي فإن الانتخابات فيها ونتائجها تؤثّر على العالم كلّه دون استثناء، خاصّة في الظروف الحالية التي تسودها فيها الخلافات الداخليّة التي تصل حدّ الكراهية العمياء، وفي ظل ازدياد الفروق الشاسعة اقتصاديًّا بين فئات الشعب الأميركيّ،
وازدياد قوة الحركات الأصوليّة والمتزمّتة الدينيّة والسياسة من اليمين واليسار، وتلك شبه النازيّة، أو النازيّة الجديدة، وازدياد حدة الحرب الاقتصاديّة بين أميركا والصين، والتي ستعود للاشتعال من جديد في حال فوز دونالد ترامب، واحتدام الصراع بينها وبين روسيا وصولًا إلى تهديدات نوويّة وأسلحة كونيّة وغيرها، وكلها أمور تزداد حدّة إذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن المرشحين المتنافسين، هما الخيار الأسوأ ربما للولايات المتحدة،
وأن ليس هناك أيّ خيار بديل لهما أمام هذه الدولة، بمعنى أن احتمال تنحيهما عن السباق الانتخابيّ الرئاسيّ ليس قائمًا، وكذلك انسحاب واحد منهما، رغم ما أصبح واضحًا من أنهما لا يتمتّعان بكامل الصحّة الجسديّة والصفاء الذهنيّ لقيادة دولة عظمى كالولايات المتحدة. وعلى ضوء زلات اللسان المحرجة والمتكرّرة للرئيس الحاليّ بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، والتي جعلت من عبد الفتاح السيسيّ رئيسًا للمكسيك، وأعادت الرئيس الفرنسيّ فرانسوا ميتران إلى الحياة، وحوَّلت اسم الملكة رانيا ، ملكة الأردن إلى الملكة ريهانا، وغيرها وغيرها من زلّات، تضاف إلى الخلافات الشديدة بينه وبين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي تؤكّد أن الرئيس بايدن،
وإن كان رئيس الدولة العظمى الوحيدة عالميًّا، إلا أنه غير قادر على التأثير على سير الأمور في الحرب الدائرة في غزة، كما أنه غير قادر على اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة، توقف الحرب ولو مؤقتًا، وحتى لو كان ذلك لوقف نزيف الأصوات خاصّة بين الأوساط الشابة والتي تتراوح أعمارها بين 18-34 عامًا، وهم العامل الذي قد يكون السبب في خسارة بايدن الانتخابات ، مقابل مرشح يبلغ من العمر 77عامًا، يواجه 91 لائحة اتهام خطيرة وتُجرى له أربع محاكَمات مختلفة، يعاني النرجسية المفرطة،
فهو الذي حاول قلب نظام الحكم والسيطرة على الكابيتول عام 2021، كما أنه لا يتمتّع بصفاء الذهن التامّ، إذ جعل من فيكتور أوربان رئيسًا لتركيا، وادّعى أن اميركا على عتبة حرب عالمية "ثانية" وتفاخر بانتصاره على باراك أوباما، وهو انتصار لم يكن فهو لم ينافس أوباما أبدًا، وانتقص من قيمة منافسته الرئاسيّة نيك هيلي، لكنّه قال إن اسمها هو نانسي بيلوسي، وكلّها زلات لسان خطيرة، لكن وقعها على الناخب الأميركيّ وعلى العالم أقلّ، فالتوقّعات من ترامب منخفضة، على ضوء ماضيه وحاضره وشخصيّته. أما بايدن فالحال معه يختلف، وبالتالي قد تكلّفه زلاته هذه ثمنًا باهظًا، مع الإشارة هنا اإلى قاسم مشترك واحد بين المرشحين الحاليين،
وهو أن معظم الناخبين في الولايات المتحدة ، كانوا يتمنون أن تكون هوية المرشحين للرئاسة مختلفة، لكنّ الواقع يشير إلى أزمة قياديّة واضحة للعيان، تجعل من الانتخابات الرئاسيّة حالة متوفرة، وفرصة أقرب لمن يملك المال والقدرة على تجنيد الدعم الماليّ، وليس المرشح الأفضل والأحقّ بالمنصب، أو صاحب المؤهّلات الأوفر.
والشيء بالشيء يذكر فمواقف بايدن من الحرب في غزة ، ودعمه لإسرائيل سياسيًّا وعسكريًّا مسّت بتأييده حتى أن بعض الفئات في أمريكا أطلقت عليه اسم"جو جينوسايد"، أي جو الذي يؤيّد إبادة شعب، وهذا يقودنا إلى اقتراحات الترحيل الطوعيّ التي طرحها سياسيّون إسرائيليّون ليسوا فقط من اليمين الدينيّ المتزمّت، بل من حزب الليكود الحاكم بمن فيهم سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة داني دانون، والوزيرة السابقة اييلت شاكيد، والحاليّة جيلا جمليئيل وزيرة شؤون الاستخبارات،
وهي اقتراحات يجب أن نقول ومن باب النزاهة التاريخيّة، أنها رافقت النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ منذ العام 1948، وعبر تعرّجات ومسمّيات عديدة منها ما يتعلّق بالأمم المتحدة ووكالتها الدولية لشؤون اللاجئين، أو وكالة الأونرا التي تشكّلت خصيصًا لغوث اللاجئين الفلسطينيّين عام 1949، والتي أرادت منها الأمم المتحدة ترتيب أمور اللاجئين الفلسطينيّين الذين بلغ عددهم حينها نحو 700 ألف مواطن، لكن المساعي الهادفة إلى حلّ أزمة اللاجئين، سواء كان ذلك عبر وكالة الأونرا،
أو الدول المجاورة في المنطقة وربما العالم ، لم تسعف ولم تجدِ نفعًا، بل إن كل الأحاديث عن توطين اللاجئين، أو ترحيلهم، أو غير ذلك من مسمّيات، كانت نتائجها معاكسة كرِّست قضية اللاجئين، وأفشلت كافّة المقترحات لحلّها، ومنها رفض إسرائيل لحقّ العودة وإصرار الفلسطينيّين عليه، ومن ثمّ موافقة إسرائيل على إعادة نحو 50 ألفًا من اللاجئين كبادرة حسن نية إنسانيّة لا تعني بأيّ حالٍ من الأحوال اعتراف إسرائيل بالمسؤوليّة التاريخيّة عن ترحيلهم، ومن ثمّ مقترحات وبرامج سياسيّة إسرائيليّة دعت إلى الترحيل القسريّ للفلسطينيّين طرحها الوزير الأسبق رحبعام زئيفي، كما أنه ورد ذكر إعادة التوطين في خطة الرئيس الأميركيّ الأسبق بيل كلينتون التي طرحت على الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ في مطلع الألفيّة الحاليّة،
ضمن المساعي لحلّ الدولتين، وتمّ بحثها عام 2007 في مفاوضات الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيليّ في حينه إيهود أولمرت. وكذلك مفاوضات طابا التي أجراها رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك عام 2001، والتي تمخّضت عن استعداد بعض الدول لاستيعاب أعداد محدودة من اللاجئين بينها الولايات المتحدة، لكن ذلك توقّف ومُني بالفشل،، وصولًا إلى الدعوة الحاليّة إلى ترحيل طوعيّ، أو قسريّ، كما طالب وزراء اليمين في مؤتمرهم في القدس قبل أسبوعين، وكلها أمور تؤكّد ما ذكرته في البداية، من ضرورة دراسة التاريخ لاستخلاص العبر ومنع تكرار الأخطاء، فإقامة مؤسّسة أمميّة خاصّة للاجئين الفلسطينيّين، والتي أرادها الجميع فرصة للحلّ، اتضح أنها كانت جزءًا من المشكلة فهي كرَّست حالة اللجوء والشتات،
وخلقت أجيالًا من اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم، قبلوا بالاعتماد عليها في توفير الماء والغذاء والمال والتعليم والعمل، دون أن يتم استخلاص العبرة، وهي ان تكرار الشعارات عن حلّ للمشكلة دون حلّها، إنما هو السبيل المضمون لتصعيدها وزيادة خطورتها، فالأجيال المتعاقبة من اللاجئين الذين ارتادوا مدارس "الأونرا" ووفقًا للمعطيات، كانت الدفيئة التي وفّرت العدد الأكبر من المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر، وهي بحكم كونها تجذب إليها خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة، كانت الأكثر تأثرًا في الفكر الأصوليّ والمتزمّت دينيًّا لحركة"حماس"، والأسهل إقناعًا بحمل السلاح، والأبعد ما يكون عن أي قبول،
أو محاولة لقبول أيّ حلّ يتّسم بالعقلانيّة بعيدًا عن القوة والسلاح، حتى لو كانت تلك اتفاقيات أوسلو من العام 1993، والتي اعتبرها كثيرون ضوءًا خافتًا في نفق النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، ناهيك عن أن الحديث إسرائيليًّا عن إعادة توطين اللاجئين، أو تهجير طوعيّ، أو قسريّ إلى دول أوروبيّة يؤكّد أن عدم استخلاص العبر التاريخيّة لا يتوقّف عند تلك القديمة منها، بل يصل حدّ عدم إجادة قراءة التاريخ الحاضر واستخلاص العبر والنتائج منه، فملايين اللاجئين الذين تدفّقوا على أوروبا قادمين من أفغانستان وسوريا والصومال والعراق وليبيا وحتى مصر،
ومؤخّرًا غزة وحتى أوكرانيا، لم يجدوا ضالّتهم ولم يصلوا الجنة المرجوة، أو جنة عدن المفقودة، بل إن ذلك رافقه سيرورة تشريعيّة وسياسيّة شهدتها الدول الأوروبيّة كانت بدايتها استقبال اللاجئين من منطلقات إنسانيّة، ثم تشديد القوانين والتعليمات والاعتبارات وختامها إغلاق حدود بعض الدول امام المهاجرين، كان أفضل تعبير عنها الاتفاق الذي تمّ توقيعه في نهاية كانون الثاني من العام الحالي 2024 بين إيطاليا وألبانيا، والذي ينصّ على إمكانيّة قيام إيطاليا بإرسال لاجئين غير شرعيّين يصلونها من الشرق الأوسط وغيرها، إلى معسكرات اعتقال في ألبانيا، عبر إقامة معسكَرَيْن يتّسعان لنحو 3000 معتقل، واتفاق مماثل وقّعته إيطاليا مع ليبيا وتونس،
قالت عنهما رئيسة مفوضيّة الاتحاد الأوروبيّ أورسولا فون در ليين،أنهما "تفكير إبداعيّ خارج الصندوق"، خاصّة وأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا عام 2023، بلغ قرابة 160 ألفًا، علمًا أن إقامة معسكرات الاعتقال المذكورة ، تم تفسيره على أنه جزء من منظومة تعني منع المهاجرين من دخول إيطاليا مباشرة، بل إخضاعهم لامتحانات ومحاولة منحهم مهنة خلال فترة مكوثهم في المعسكرات، ثم السماح لمن يحصلون على تأشيرة الدخول ويستوفون الشروط، بدخول أوروبا ، على أن يتمّ إبعاد من لا يستوفي الشروط من قبل السلطات الألبانيّة إلى مسقط رأسه، علمًا أن أعداد المهاجرين إلى دول أوروبا وحتى استراليا تسجّل أرقامًا قياسيّة، إذ بلغ عدد المهاجرين إلى أستراليا عام 2023 ( حزيران 2022- حزيران 2023) نحو 520 ألفًا، وبلغ عدد المهاجرين المكسيكيّين إلى أمريكا، قرابة 2.5 مليون نسمة، بينما شهدت إيرلندا مواجهات عنيفة بين مواطنيها والسلطات الرسميّة جرّاء سياسة الهجرة والقوانين المخففة التي سنتها الحكومة، ما معناه أن الدول الأوروبيّة،
أو أميركا لم تعد العنوان لحلّ مشاكل المهاجرين واللاجئين، وكم بالحريّ إذا كانوا قادمين من غزة التي تحكمها "حماس"، ونتيجة لحرب بدأت بعد اقتحام بلدات إسرائيليّة وقتل نحو 1400 مواطن إسرائيليّ في السابع من أكتوبر، وفي وقت تم فيه حتى الآن إجلاء حوالي 125 ألف إسرائيليّ من البلدات الجنوبيّة المتاخمة لغزة، والبلدات الشماليّة في منطقة الجليل المتاخمة للحدود مع لبنان، تم نقلهم إلى الفنادق بتمويل من الوزارات الحكوميّة، بعكس ما يحدث في قطاع غزة من رحيل طوعيّ، أو قسريّ من شماله إلى جنوبه، ودمار واسع النطاق لحق بالمباني والمنشآت الضروريّة في غزة ،دون اكتراث من السلطة الحاكمة هناك.
هذا يقودنا إلى القضية الثالثة والسؤال الهامّ حول ما إذا كانت القيادة الفلسطينيّة في القطاع، وتحديدًا حركة "حماس" ، قد مارست "حساب الذات" حول سياساتها التي أدّت إلى السابع من أكتوبر، وما بعده من أضرار وخسائر بشريّة وماديّة واجتماعيّة لحقت بغزة دون استثناء، وما إذا كانوا قد أعادوا التفكير مرة أخرى في جدوى وملابسات ما حدث، وما إذا كانت هذه القيادة أصلًا قد أعادت التفكير والنظر بكلّ ما فعلته في القطاع، منذ عام 2007، بل منذ انسحاب إسرائيل منه عام 2005 من طرف واحد، وذلك رغم أن إسرائيل واصلت السيطرة على مداخل ومخارج القطاع ومحاصرته، والمقصود هنا أن "حماس" وبقرار واعٍ ومتواصل فضّلت استثمار ملايين، بل مئات ملايين الدولارات التي وصلتها من قطر والدول الداعمة في تسليح أفرادها وبناء أنفاق عسكريّة، دون بناء وتعزيز مؤسّسات المجتمع في كافّة مجالات الحياة، أي دون أن تمارس صلاحيتها، بل مسؤوليتها كسلطة حاكمة في القطاع وملخّصها الاهتمام بالمواطن والمصلحة العامّة والجماعيّة، وأنها فضلت السعي لإقامة ولاية، أو دولة شريعة إسلاميّة بكل ما يحمله ذلك من غبن لجماعات غير إسلاميّة وللنساء، بدلًا من السعي لبناء دولة متحضّرة تملك مقوّمات العيش والحياة والتقدّم والتطور، وسط تعايش سلميّ مع الجوار، أو الامتناع عن صدامات عسكريّة، بدل السعي إليها، بل تكرارها.
ما نشهده اليوم على صعيد الأمور الثلاثة سابقة الذكر ليس مفاجئًا، بل هناك من حذَّر من أن حدوثه، هو مسألة وقت ليس إلا، فكثيرون حذّروا من مغبّات توجه إسرائيل إلى اليمين، ومحاولات تجاهل ضرورة حلّ النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، والانسياق وراء أجندات المستوطنين واليمينيّين، سياسيًّا واقتصاديًّا وقضائيًّا، وأكدوا أنها سياسات سوف تصل حدّ الانفجار غير القابل للحلّ، منهم الصحفي الراحل زئيف شيف الذي كتب عام 1985، في صحيفة "هآرتس" أن سياسات الليكود وتحالفاته، تعني أنه يقود إلى دولة ثنائيّة القوميّة، ويرفض إمكانيّة إقامة وطن، أو كيان فلسطينيّ، ما سيقود إلى مزيد من الاستعداد والقابليّة للتطرّف وازدياد أعداد أولئك من الفلسطينيّين الذين يقبلون بتنفيذ عمليّات ونشاطات عسكريّة ضد إسرائيل،
وعمليّات قتل لليهود لن يقبلها أحد بمن فيهم أولئك من اليهود الذين يمكن وصفهم بالمعتدلين، وبالتالي تزداد أعداد من يؤمنون بالفكر العنصريّ من نهج الحاخام كهانا والأفكار الترحيليّة، بينما كتب البروفيسور زئيف شترنهال عام 1987 وكأنه يصف ما يحدث اليوم من تخوين للمطالبين بوقف الحرب والاستيطان ، وتخوين لكلّ من لا يتساوق مع الدعوات إلى التمييز ضد العرب والانتقاص من الديمقراطيّة، وإخضاع الجهاز القضائيّ وتخويفه، أو يدعو إلى هدنة وعدم مواصلة القصف والاكتراث بأعداد الضحايا. إن إسرائيل الحاليّة هي مختبر تتم فيه تجربة سياسيّة مثيرة قوامها السؤال متى ستسقط آخر معاقل الاعتدال والديمقراطيّة والعقلانيّة فيها، ومتى ستنهار القيم الديمقراطيّة على ضوء استمرار سياسة التمييز والتضييق ضد المواطنين العرب في إسرائيل واليساريّين اليهود وجهاز القضاء ،والرغبة في تسييسه وصبغه بصبغة أيديولوجيّة متطرّفة، ولعلّ من سخريات القدر، أو محاسن الصدف، أن تتزامن كتابة هذه الكلمات مع معلومات رشحت عن جلسة لجنة تعيين القضاة في إسرائيل ،
طالبت عضو فيها هي الوزيرة اليمينيّة أوريت ستروك بعدم ترقية قاضية ما بادّعاء أنها "غير متزمّتة قوميًّا بما فيه الكفاية"، مؤكّدًا أن انهيار الديمقراطيّة، وحقوق المواطن لا يتم بفعل حروب خارجيّة، بل من الداخل. أما أمريكا فحالها لا يختلف فديمقراطيّتها بائسة ويمينها يحاول السيطرة على المحاكم عبر تعيين قضاة محافظين يدينون بالولاء لترامب، وإقصاء لفئات مهمّشة وضعيفة، وتكريس لسيطرة رأس المال وانغلاق داخلّي، ما تعكسه نتائج استطلاعات رأي تشير إلى أن نحو نصف الأميركيين يميلون إلى الاعتقاد أن حربًا أهليّة داخليّة أصبحت واردة بالحسبان.
خلاصة القول، أن عدم الاستفادة من مراجعة التاريخ ودراسته واستخلاص عبره الصحيحة نتيجته واحدة، وهي أن تتكرّر الأحداث كمأساة، وهذا ما يمكن قوله عن الحالات الثلاث سابقة الذكر، مأساة يمكن تخفيف حدّتها، إذا قرر الزعماء في الحالات الثلاث أنهم يريدون أن يسطّر التاريخ أسماءهم كمن عملوا للمصلحة العامّة وحملوا رسالة إنسانيّة تعود بالفائدة على شعوبهم، أو ضمن خانة من غيّروا التاريخ، ووضعوا بصماتهم على صفحته، وليس ضمن من استخدموا السلطة لقمع داخليّ ومصالح فئويّة ضيّقة.!!!