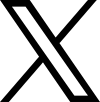هل القوّة تصنع الحقّ أم الحقّ يصنع القوّة؟
هذا الديالكتيك الثابت يتجلّى في العودة إلى صراع بين مفهومين يحملان في طيّاتهما المعاني الكثيرة المتعلّقة بحياتنا اليوميّة من جهة وحياة العالم والعلاقات بين الدول من جهة أخرى، وذلك بما يعنيه من معانٍ واسعة وخطيرة تحدّد المستقبل ومن خلال توظيفه إيجابيًّا يمكن منع المعاناة والصراعات ووقف المآسي والمجازر ، وبضمن ذلك تحدّد الخطوات التي يتّخذها العالم ومؤسّساته والقوى العظمى فيه، خاصّة لوقف الصراعات وإنهاء معاناة الشعوب ومعاقبة المتسبّب فيها.

ومحاولة تفكيك أسباب امتناع العالم عن اتّخاذ هذه الخطوات اللازمة وتبنّيها، وسنقف عليها بالتحليل والأمثلة، فالصراع بين طرحين أوّلهما أنّ "الحقّ يصنع القوة" يعني أنّ الحقّ والعدل هما الأساس الذي تقوم عليه القوّة الحقيقيّة، وأنّ القوّة المستمدّة من الظلم والباطل لا تدوم، فعلى العالم أن يحبط استدامتها، وهذا أساس قامت عليه المؤسّسات الدوليّة ومنها الأمم المتّحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدوليّة وغيرها، أمّا الطرح الثاني القائل بأنّ "القوّة تصنع الحق" فيعني أنّ من يملك القوّة يفرض إرادته ويجعلها هي الحقّ
وهو صراع أتطرّق إليه هنا بفرض خوض نقاش موضوعيّ وقيميّ من رغبة واصرار على رسم صورة واقعيّة وحقيقيّة لعالمنا الحاليّ، الذي يشهد حالة لم يسبق لها مثيل من البون الشاسع ما بين القول والفعل في كافة القضايا والمواضيع ابتداءً من حياتنا الخاصّة ومنظومة القيم الاجتماعيّة والمبدئيّة التي نحملها مرورًا بالتفسيرات المشوّهة بل والخطيرة للفوارق في المواقف والمعتقدات والممارسات السيّئة والفتّاكة باسم الدين، فهي تجعله أداةً ومبرّرًا للفرقة والتنافر والتناحر والقتل، بدلًا من كونه، على اختلاف مذاهبه وتوجّهاته وانتماءاته، وسيلة للحوار والتفاهم ونظام للعلاقات التي تبنى على التفاهم والسلام باعتبار الإنسان القيمة العليا، والصلح غاية سامية ورفيعة، وصيانة حياة الناس أينما كانوا أمرًا إلاهيًّا ووصيّة لنصرة الضعيف ورفض الاستقواء عليه، وصيانة أمن وأمان أبناء المذاهب والديانات الأخرى، وصولًا إلى السياسة المحلّيّة والقطريّة والدوليّة وتصرّفات الدول وسياساتها ورغبتها أو سعيها إلى تطبيق ما نصّته بذاتها ووافقت عليه من قرارات ونصوص دوليّة صدرت عن الأمم المتّحدة والمحاكم الدوليّة ونماذج عمل خاصّة في الأزمات الدولية، بل لتأكيد الحالات التي تتكرّر في العقود الأخيرة، وملخّصها تنازل طوعيّ عن القيم التي تتلاءم والطرح الأوّل حول الحقّ كمصدر للقوّة
ومعنى ذلك نصرة أصحاب الحقّ مهما وأينما كانوا، وحمايتهم ومنع المسّ بهم، أو صياغة مقياس واضح يطبّق دائمًا يتحرك العالم وفقه لحماية ودعم أصحاب الحقّ ومنحهم القوّة والعدالة، ومنع إجبارهم على التنازل عن حقوقهم ومنع المسّ بهم وارتكاب الاعتداءات عليهم او حمايتهم من الأخطار المترتّبة على النزاعات والحروب التي تمسّ حياتهم وحرّيّتهم، وبكلمات أوضح ،عدم جعل هذه الأمور عرضةً للنقاش من جهة بل صياغة ردود مشابهة للحالات المتشابهة، وليس العكس، أي ليس "تفصيل الردّ" على مقاس الأطراف المشاركة أو ذات العلاقة فيه وأهوائها ، فالانتقائيّة في تطبيق القرارات والقوانين والشرائع القضائيّة والإنسانيّة، وهي ظاهرة برزت خاصّة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، خاصّة بعد حربي الخليج الأولى والثانية والحرب الأهليّة في يوغسلافيا وإرسال الدول الأوروبيّة قوّات لمنع ارتكاب الصرب مجازر تطهير عرقيّ ضدّ الألبان في منطقة كوسوفو عام 1999، واستخدام القوّة ضدّ ليبيا عام 2011 بحجّة منع سلطاتها المركزيّة من ارتكاب ما وصفه العالم بجرائم حرب ضدّ الشعب الليبيّ.
إنّ هذه التوطئة ليست نقاشًا فلسفيًّا بل عرض لحالة حقيقيّذة أدركتها المحافل الدوليّة على ضوء أحداث شهدها العالم، منها الحروب الأهليّة في يوغسلافيا والخلافات الطائفيّة والقبائليّة في إفريقيا بما فيها الحرب بين السودان المسلم وجنوب السودان ذي الأغلبيّة المسيحيّة والأحوال المتوتّرة في آسيا خاصّة في بورما (ميانمار)، و كذلك الشرق الأوسط ، وهي ضرورة وجود منظومة دوليّة جامعة واضحة المعالم والأسس والقوانين، تعمل أينما كان الخلاف، بغضّ النظر عن أطرافه وهويّاتها وانتمائها السياسيّ وقربها ودعمها من الدول العظمى، فعلى المنظومة حماية السكان من الإبادة الجماعيّة وجرائم الحرب والتطهير العرقيّ والجرائم ضدّ الإنسانيّة وفق التعريف الدوليّ المتّفق عليه ، وهو ما دفع قادة العالم كلّه عام 2005، وكما جاء في الوثيقة الختاميّة لمؤتمر القمّة العالمية لعام 2005، والتي عُقدت في الفترة من 14 إلى 16 أيلول سبتمبر في مقرّ الأمم المتّحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتّحدة ، بمشاركة أكثر من 170 رئيس دولة وحكومة، إلى إقرار مبدأ وقرار " مسؤوليّة الحماية" والذي نصّ على ضرورة ضمان آليّة لتطبيق المسؤوليّة عن حماية السكّان من الإبادة الجماعيّة وجرائم الحرب والتطهير العرقيّ والجرائم ضدّ الإنسانيّة، ويتضمّن ذلك مسؤوليّة كلّ دولة على حماية سكّانها ( وكلّ الخاضعين لسيطرتها) من الإبادة الجماعيّة وجرائم الحرب والتطهير العرقيّ والجرائم ضدّ الإنسانيّة.
وتتضمّن هذه المسؤوليّة منع مثل هذه الجرائم، بما في ذلك التحريض عليها، من خلال الإجراءات المناسبة والضروريّة، إضافة إلى ما نصّت عليه الفقرة 139 في الوثيقة الختاميّة من أنّ "المجتمع الدوليّ، من خلال الأمم المتّحدة، مسؤول كذلك عن استخدام الوسائل الدبلوماسيّة والإنسانيّة وغيرها من الوسائل السلميّة المناسبة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعيّة وجرائم الحرب والتطهير العرقيّ والجرائم ضد الإنسانيّة"
وهي وثيقة كان من المفروض أن تضمن الأمن والأمان وأن تمنع سفك دماء الأبرياء سواء من قبل حكوماتهم كما حدث خلال الحرب الأهليّة في سوريا أو العراق تحت حكم داعش وما لحق من أعمال قتل بالأكراد واليزيديين والمسيحيّين، أو تلك المتواصلة اليوم في السودان أو ما حدث في ليبيا، وكلّها أحداث مسّت بحياة الناس وخلقت أمواجًا من الهجرة والنزوح وأوقعت ملايين القتلى والجرحى، أو ما حدث ويحدث في سوريا مؤخرًا من اعتداءات ومذابح ضدّ الدروز ، وما يحدث في غزّة منذ أشهر من أعمال وصلت باعتراف العالم كلّه إلى مجاعة وهدم مقوّمات الحياة كافّة، وسقوط عشرات آلاف الضحايا بمن فيهم النساء والأطفال ومنع الموادّ الطبّيّة وغيرها، وكلّها قضايا كان من المفروض أن تدفع دول العالم ومؤسّساته الدوليّة الموقّعة على "ميثاق مسؤوليّة الحماية" إلى استخدام كافة الوسائل السياسيّة والاقتصاديّة وحتّى العسكريّة وفرض العقوبات المتنوّعة لمنع ووقف ذلك، دون أن يتمّ هذا على أرض الواقع، والأسباب واضحة للعيان، يمكن اختصارها في كلمة واحدة وهي"سياسيّة" أو جملة واحدة وهي " المصالح السياسيّة الضيّقة" أو بمصطلح قانونيّ وهو " الانتقائيّة في تطبيق القوانين والمواثيق".
إنّ نظرة سريعة تبدأ من ألآني وتعود إلى الخلف كفيلة بالقول إنّه في ظروف عاديّة، ولو لم تكن هناك اعتبارات سياسيّة دوليّة خاصّة من قبل الدول العظمى، وفي يومنا هذا لا دولة عظمى غير الولايات المتّحدة الأميركيّة، كان من المفروض أو حتّى المفروغ منه والمفهوم ضمنًا، أن تهبّ المجتمعات الدوليّة إذا اعتبرنا العالم قرية واحدة للدفاع عن السكّان المدنيّين في غزّة، والذين يعانون حربًا من اثنين وعشرين شهرًا وقد دفعوا ثمنها غاليًا جراء العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة، فالمدنيّون لا بدّ من القول أنّهم عانوا الاعتداءات والتنكيل من السلطة الحاكمة هناك، أي حركة "حماس" التي صادرت حرّيّتهم واعتدت على أجسادهم وأزهقت أرواحهم ومسّت بإمكانيّات عيشهم بكرامة وداست حقوقهم الأساسيّة قبل الحرب ومنذ سيطرتها على القطاع عام 2007، فعلى المجتمعات الدوليّة أن تهبّ للدفاع عن الأقلّيّة الدرزيّة في سوريا ومنع المذابح التي تعرّضت لها، وقبل ذلك وفي نفس السياق السوريّ ، الدفاع عن العلويّين في الساحل الشماليّ، وقبلها الحرب الأهليّة في سوريا وفظائع داعش في العراق، والأعتداءات التي حصلت على الأقلّيّة المسيحيّة عبر استخدام وسائل نصّ عليها ميثاق مسؤوليّة الحماية، ومنها الضغط الدبلوماسيّ والعقوبات السياسيّة والاقتصاديّة ومنع تصدير الأسلحة وعقوبات شخصيّة على قياداتها ووقف اتّفاقيّات التعاون
وإذا لم ينفع كلّ ذلك، فيجب اتّخاذ خطوات عسكريّة دوليّة جماعيّة لوقف ذلك، بعد أن فشلت، بما يخصّ غزّة، قرارات مجلس الأمن الدوليّ من شهر آذار 2024 وقرارات محكمة الجنايات الدوليّة ومحكمة العدل الدوليّة، والتي دعت كلّها إسرائيل إلى وقف الحرب ومنع كارثة إنسانيّة في القطاع، مع الإشارة إلى تأخير أو تأخّر الجالية الدولية حتّى في ممارسة أبسط أنواع الضغط على نظام أحمد الشرع لحماية الأقلّيّات في سوريا أو إسرائيل لحماية المدنيّين، وصولًا الى ممارسة ذلك مؤخّرًا وما تتمّ تسميته "التسونامي السياسيّ والدبلوماسيّ" ضدّ إسرائيل وإعلان عدد كبير من الدول الأوروبيّة الاعتراف بدولة فلسطين أو عقد النيّة على ذلك، مع التنويه إلى الحالة الآنيّة وملخّصها أنّ لا قيمة ولا تأثير لأيّ قرار دوليّ أو أوروبيّ بخصوص سوريا أو غزّة، وذلك لأنّ الولايات المتّحدة والتي وقّعت على ميثاق مسؤوليّة الحماية، تستخدم حقّ النقض "الفيتو" تلقائيًّا ضدّ أيّ قرار يحاول إلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزّة أو فرض عقوبات على نظام أحمد الشرع في سوريا، مقابل إسراعها إلى اتّخاذ قرارات تشير إلى تقديمها الدعم العسكري لأوكرانيا وفرض العقوبات على دولة عضو دائم في مجلس الأمن هي روسيا، في تأكيد صارخ للانتقائيّة المقيتة في تطبيق القرارات والتشريعات الدوليّة حتّى لو يتعلّق ذلك بمنع الإبادة الجماعيّة والتصفية العرقيّة.
ما سبق يؤكد وضعًا غير مسبوق عالميًّا يثبت أنّ العقبة الرئيسيّة التي تمنع استتباب الأمن بسرعة ووقف المجازر والحروب الأهليّة خاصّة في العقدين الأخيرين، هي المصالح السياسيّة القويّة من جانب الدول الكبرى التي كان من المفروض ووفق مبدأ " مسؤوليّة الحماية" أن تعمل ليس فقط على منع المسّ بالمدنيين والإبادة الجماعيّة خلال الحروب والأزمات بل ووفق ميثاقها، اتّخاذ خطوات وقائيّة لمنع ذلك، لكنّها تفعل غير ذلك وتنتهج الانتقائيّة في تطبيق السياسات والقرارات والقوانين والشرائع الدوليّة، وهو ما اتّضح خاصّة في حالة قطاع غزّة والأعتداء السافر على الدروز في سوريا، وأكاد أجزم هنا أنّ أحدًا لم يفكر أصلًا ولم يخطر بباله أن يهاجم إسرائيل أو سوريا أو حتّى أن يفرض عليهما العقوبات الاقتصاديّة أو فرض الحظر الجوّيّ أو الحصار البحريّ كما حصل في ليبيا والعراق، وكم بالحريّ أنّ أحدًا لم ولن يفكر بإرسال قوّات عسكريّة تفصل بين الغزّيّين وقوّات الجيش الإسرائيليّ أو بين مسلّحي النظام السوري وجبل الدروز، وهي خطوة كانت ستوقف الحرب خاصّة وأنّ إسرائيل لن تحارب قوّات أوروبيّة، وربّما الشرع لا يريد الحرب على العالم من منطلق " الحقّ يصنع القوّة" أي كما فعلت أمريكا
وانطلاقًا من موقف يقول أنّ حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها والردّ على فظائع "حماس" وما رشح من اعتداءات جنسيّة وعمليّات اختطاف لمسنّين وأطفال كرهائن، وغيرها بحقّ المدنيّين الإسرائيليّين، تمّ اعتبارها جرائم ضدّ الإنسانيّة ،وهو الموقف ذاته من الدول الأوروبيّة، ولكن يبدو أنّ الأمر تغيّر قليلًا، فقوّة المأساة التي حلّت بغزّة جرّاء اثنين وعشرين شهرًا من الحرب والمذابح في جبل العرب منحت الدول الأوروبيّة الحقّ في اتّخاذ خطوات منها إعلان نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين، ولكن حتّى هذه الدول لم تفكّر بأيّ خطوة إضافيّة يمكن اعتبارها جزءًا من "مسؤوليّة الحماية" وفق ميثاقها من العام 2005، باستثناء خطوات رمزيّة منها انزال طرود غذائيّة، والسبب واضح للعيان، فهي تدرك أنّ الدولة العظمى الوحيدة في العالم وهي الولايات المتّحدة، ستمنع اتّخاذ أيّ قرار دوليّ ملزم بهذا الشأن خاصّة في مجلس الأمن ، كما أنّ هذه الدول تدرك أنّ إسرائيل لا ولن تقيم وزنًا لأيّ قرار دوليّ أو أوروبيّ طالما واصلت الولايات المتّحدة دعمها المطلق سياسيًّا وعسكريًّا، وطالما واصلت إدارة ترامب وقبلها إدارة بايدن، قصقصة أجنحة المحاكم الدوليّة ورفض قراراتها وتقليص صلاحيّاتها
وطالما واصلت الدول الأوروبيّة حساباتها السياسيّة والاقتصاديّة والأخرى والتي تعتبر إسرائيل جزءًا من العالم الغربيّ وسوريا الشرع عميلة لأمريكا والحلف الأطلسيّ ومشاركةً فعَّالة في " الجدار الحديديّ" المناوئ للتغلغل الإسلاميّ في أوروبا، وبالتالي ستواصل هذه الدول التفرّج على حالة المجاعة والدمار والقتل والاقتلاع في غزّة، مكتفية بالتنديد والشجب وبالتلويح بنيّة الاعتراف بدولة فلسطين في الشهر القادم، لا يعرف أحد ما إذا كانت ستتمّ، وهو ما كان عند اندلاع الحرب الأهليّة في سوريا عام 2011، ومستمرّ عبر قتل جماعيّ لدروز الجبل حين عرقلت بعض الدول ومنها دول عظمى، في حينه، ومنها روسيا، اتّخاذ إجراءات دوليّة جماعيّة حاسمة في هذه الحرب التي شهدت فظائع لا توصف واستخدام للأسلحة الكيماويّة في غوطة دمشق وإلقاء متواصل للبراميل المفخّخة، والنتيجة مقتل قرابة مليون مدنيّ سوريّ وتهجير الملايين ومسّ بالأقلّيّات والمواقع الأثريّة ومقوّمات الحياة، دون ردّ، وكلّ ذلك انطلاقًا من مصالح سياسيّة واقتصاديّة، ناهيك عن أنّ هذه الحرب وفظائعها لم تدفع حتّى الدول العربيّة إلى التحرّك ومناصرة المدنيّين، بخلاف ما حدث في اليمن والحرب التي شنّتها الدول العربيّة، وانطلاقًا من مبدأ مسؤوليّة الحماية، ضدّ الحوثيّين في اليمن والتي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" وشاركت فيها السعوديّة والإمارات والبحرين والكويت وقطر(تمّ استبعادها لاحقًا)، وحتّى مصر والأردن بمشاركة رمزيّة، عبر حملة عسكريّة ضمّت 185 طائرة مقاتلة، ومئات آلاف الجنود منعًا لاستيلاء الحوثيّين على اليمن ومنعًا للمسّ بحياة المدنيّين هناك.
كلّ هذا يلخّص حالة العالم اليوم، المتمثّلة بالمزاجيّة والتذبذب القيميّ والسياسيّ، والانتقائيّة في تطبيق السياسات والتشريعات الواضحة الّتي تحكمها مواثيق دوليّة ومواقف دولية وليست محصورة بمواقف دولة واحدة دون غيرها، يخشاها الآخرون وبالتالي يحاولون التغطية على عجزهم وخوفهم منها بتصريحات سياسيّة منمّقة لكنّها لا تتعدّى مرحلة التصريح والتلميح إلى التطبيق والتنفيذ، وهذا ما جاء على لسان صحيفة "نيويورك تايمز" وعبر مقال للكاتبة الصحفيّة الأمريكيّة ليديا بولغرين، إذ انتقدت انتقائيّة الغرب في تطبيق معايير النظام الدوليّ القائم على القوانين والنظم، وامتناعه منذ العام 1948 عامّة وخلال العامين الأخيرين خاصة عن تطبيقها على إسرائيل، بدءًا من قرارات الأمم المتّحدة المطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلّة وفي مقدمتها القرارين 242، 338، والقرارات ضدّ الجدار الفاصل وبضمنها قرارات محكمة العدل الدوليّة المتعلّقة به، وكذلك ما يتعلّق باتّفاقيّات منع انتشار الأسلحة الكيماويّة والنوويّة، بعكس الموقف الأوروبيّ والعالميّ من عراق صدام حسين والذي اتّضح أنّه لم يكن يملك أسلحة كيماويّة، وموقف أميركا خاصّة من المشروع النوويّ الإيرانيّ، وذروتها مشاركة الولايات المتّحدة في قصف المنشآت النوويّة الإيرانيّة في حزيران 2025، وقبلها العقوبات الاقتصاديّة والسياسيّة على إيران، والموقف ممّا يحدث في غزّة منذ السابع من أكتوبر 2023،
وهو ما وصفته الكاتبة بأنّ العالم (إزاء ما يحدث في غزّة) شهد العام الماضي حدثًا مذهلًا وخطيرًا دارت أحداثه في مدينة لاهاي الهولنديّة، مقرّ محكمة العدل الدوليّة، وبغض النظر عن نتيجة ذلك، فإنّ ما حدث يثير الأسئلة حول مغزى وقيم ما يسمّى بالنظام العالميّ القائم على القواعد والأنظمة والقرارات الأمميّة والدوليّة الملزمة، وتساءلت أنّه إذا كانت هذه القواعد لا تطبّق عندما لا تريد لها الدول القويّة أن تُطبّق، فهل تبقى في هذه الحالة قواعد؟ وهذه مسألة مهمّة تعكس التحدّيات التي تواجه النظام العالميّ خاصّة في العقدين الأخيرين بقيادة الولايات المتّحدة، ويشكّل الدليل لمن لم يعرف من قبل، على خطورة اتّساع الفجوة بين قرارات الأمم المتّحدة والقرارات الدوليّة وبين تطبيقها، وهو صراع ليس بجديد، فالأمم المتّحدة تسعى إلى تطبيق قراراتها، لكنها كي تحقّق ذلك فهي بحاجة إلى تعاون الدول معها وانصياع هذه الدول للقرارات، لكن هذا الأمر يواجه صعوبات كبيرة بسبب اختلاف المصالح والتباين في القوى سواء بين الدول الأعضاء فيها وخاصّة بين الدول الكبرى.
خلاصة القول، ورغم أنّ الانتقائيّة هي حالة تلازم معظمنا كأفراد فنختار ما نريد وما يعجبنا ونترك ما لا يفي بذلك، فإنّ هذا التوجّه ينعكس علينا كأفراد فقط، بينما حين تتبنّاه حكومات ودول فإنّه يحمل انعكاسات وترتّبات خطيرة وسلبيّة للغاية على منظومات العدالة والأخلاق والثقة داخل شرائح المجتمعات في الدولة الواحدة، وقد يؤدى مواصلة تبنّي الانتقائيّة وتنفيذ السياسات الخاطئة، من كبت لحرّيّات الأقلّيّات ومسّ بحقوقها وبالمقابل إعطاء ميزات لشرائح دون غيرهم واتّباع سياسات خاطئة فقد يعود هذا النهج بالضرر على الدول نفسها وعلى المواطنين، لكنّ هذا الانتقائيّة تكون أخطر إذا كانت السمة السائدة في السياسات الدوليّة والنظام الدوليّ وخاصّة حين يتعلّق الأمر بتطبيق سياسات وتشريعات دوليّة، في التعامل مع المآسي والكوارث والإبادة الجماعيّة والدمار والخراب، وعدم الجدّ في السعي إلى وقف الحروب، ولا تستطيع كبح جماح دول وحكامٍ يريدون المزيد من الحرب والدمار لأسباب عديدة ومتعدّدة، داخليّة وخارجيّة وربّذما تاريخيّة،
وهي حالة تتكرّر في العقود الأخيرة وتكرّرت ، بوضوح كبير، في الأحداث الأخيرة والحرب المتواصلة في غزّة ومقابلها حرب إيران، والموقف من "حزب الله" وإصرار أميركا على نزع سلاحه، وبالمقابل " التسامح الكبير " مقابل أحمد الشرع ورفع العقوبات عنه ومسامحته على ما اقترفه مؤيّدوه واتباعه من مجازر ضد العلويّين في الساحل الشماليّ والمسيحيّين في دمشق والأقلّيّة الدرزيّة في منطقة السويداء، وبالتالي وهو الاستنتاج الختاميّ والمقلق ، يمكن القول إنّ العالم اليوم بقيادة قطبه الواحد، يندفع وبتهوّر مخيف نحو عصر جديد من السياسة والتصرّفات ، على الصعيد الأقتصاديّ أيضًا، وفق قاعدة "القوّة تصنع الحقّ"، فكلّ شيء فيه جائز للطرف القويّ، أو الطرف المدعوم من دولة قويّة، بينما تُداس وتزدرى القوانين والأعراف الدوليّة وحقوق الضعفاء والأقلّيّات، ويصبح اقتلاع شجرة القويّ جريمة لا تغتفر، وقتل الإنسان الضعيف أو ابن الأقلّيّات، مسألة فيها نظر، والأخطر من ذلك استخدام الانتقائيّة المدعومة بالقوّة لقلب الموازين وتوجيه التهمة للضعيف والمظلوم وتحميله وزر الظلم الواقع عليه وصولًا إلى القول الشهير لعالِم الرياضيّات الألمانيّ ديفيد هلبرت: "من أشدّ أنواع الظلم، أن يلعب الظالم دور المظلوم وأن يتّهم المظلوم أنّه ظالم". حقًّا إنّ "كلّ ما نراه من فوضى في الخارج هو أنعكاس لفوضى الداخل، فإن أردت أن ترى العالم أجمل فابدأ بتهذيب روحك وكأنّك ترتّب بيتًا ليستقبل ملكًا عظيمًا".